
د. عبد المجيد الصغيَّر
جامعة محمد الخامس – الرباط
مقدمة
في خضم تعدد الرؤى الفلسفية والدينية إلى القيم الأخلاقية، وتباين التأويلات والمقاربات للمفاهيم المؤطرة لمختلف التجارب والمواقف العملية، وتعدد الأسباب التي أوجبت الخلاف حول الإجراءات الناجعة لضبط وتقويم السلوك الإنساني، الفردي والجماعي؛ لا يجد المفكر بداً من التذكير، خصوصاً في مثل هذا المقام وداخل هذا الحرم الجامعي، من وجوب التزام منهجية فلسفية قائمة على أساس المقاربة الاستدلالية والمقارنة العقلية بين مختلف الطروحات والتنظيرات الأخلاقية، واختبار منطقها واستشراف آثارها ومآلاتها...
ولا شك أن الالتزام بهذه المنهجية وما تتطلبه من تحليل مفاهيمي وما تستتبعه من تقييمات وأحكام مشفوعة ومبررة بأدلتها وحيثياتها يستلزم وجوب التمييز الواضح بين «الشواهد المثلى» والنصوص المؤسِّسة لتقليد فكري أو أخلاقيٍّ ما وما أُلحق بتلك الشواهد والنصوص من تأويلات وقراءات أُنشئت إنشاءً من طرف المتلقين لها والقارئين لمضامينها؛ ومن ثَمّ وجب أن نشدِّد مثلاً على ضرورة التمييز الواضح بين النصوص المؤسسة وبين تاريخ تأويلها، كما هو حاصل مثلاً بالنسبة للنصوص الأفلاطونية والأرسطية في الحقل الفلسفي، حيث لا يجوز منطقياً الخلط بين مواقف أرسطو واختياراته الفكرية وبين قُرّاء هذا الفكر داخل التراث المسيحي الوسطوي أو في التداول الإسلامي أو داخل تراث عصر النهضة الأوروبي، ولا شك أن هذا الأمر الحاصل داخل التراث الفلسفي يصدق بالأولى على النصوص التأسيسية للأديان، خصوصاً منها نصوص الأديان الكتابية التي كان لها في تاريخ الإنسانية حضور قوي ودائم بين الأتباع والقرّاء ومختلف المتلقين لها.
غير أن ذلك التمييز الضروري المنوّه به هنا بين النص الفلسفي أو الديني وبين قرّائه، يستتبع بذاته وجوب التمييز بين النصوص ذاتها وإن انتمت لنفس الحقل المعرفي؛ فلا يجوز الحكم على مختلف النصوص المنتمية لنفس الحقل المعرفي حكماً واحداً، إذ في ذلك إسقاطٌ لا مبرر له علمياً وفيه قبل ذلك خلط بين النصوص وتجاهل لخصوصياتها وغفلة عن ظرفيتها التاريخية وسياقاتها الدلالية؛ فليست النصوص الفلسفية مثلاً نصاً واحداً، لأنه قد يوجد بينها من التباين والاختلاف ما يستدعي التمييز بل الفصل المطلق بينها، سواء من حيث بنية التركيب أو من حيث الأسس والمفاهيم والمآلات... فشتّان ما بين النص الأرسطي والنص السفسطائي والنص الرّواقي، وكلها نصوص فلسفية: ونفس الأمر يقال عن النصوص السياسية، فالرؤية إلى المجتمع وإلى تدبير الشأن العام في النص السياسي الديمقراطي ليست هي ذات الرؤية في النص السياسي الممجّد للحكم المطلق والاستبداد بالأمر، وكلاهما نص سياسي...
وذلك هو التمييز الواجب استصحابه بخصوص النصوص الدينية، فمن الخطأ التعامل مع هذه الأخيرة وكأنها ذات بنية واحدة تبيح لنا أن نقيّمها تقييماً واحداً وبكيفية اعتباطية كما درج على ذلك غالباً الفكر العلماني في تعامله مع الأديان جملة؛ ولقد كان محمد أركون أوضح من يمثل مثل هذا لتعامل الإسقاطي مع النص إلإسلامي...
لأجل ذلك يجب القول أنه ليس هنالك في الواقع «الدين» بالمطلق، بل هناك أديان تختلف فيما بينها اختلافاً قليلاً أو كثيراً، مثلها في ذلك مثل اختلاف المذاهب الفلسفية والسياسية والأخلاقية، مما يستوجب الحذر من إطلاق الأحكام العامة والمسارعة إلى التقييمات الجاهزة اعتماداً فقط على حقل معرفي خاص ينتمي إليه اتجاه فلسفي أو ديني محدود...
نعم! ليس هناك شك في طموح المفكر المعاصر إلى إعادة فهم تلك النصوص التأسيسية الدينية أو الفلسفية أو الأخلاقية ومحاولته إعادة «قراءتها» وتأويلها؛ غير أن هذا الطموح الفكري المشروع مشروط كما نعلم باحترام الضوابط اللغوية والبنيوية لتلك النصوص وعدم الجنوح إلى التضحية باللغة الطبيعية للنص ولَيِّها لَيّاً حتى تستجيب لتأويلات إسقاطية تفرضها ظروف وهموم القارئ ولا تنسجم ربما مع طبيعة النص المؤول وآفاقه المعرفية. ولعل أوضح مثال على هذه التأويلات الإسقاطية محاولة فيلون الأسكندري (بعد 54 م) قديماً إعادة قراءة النص الديني التوراتي بغرض التخفيف من نزعته التجسيمية الفجّة، وذلك في ضوء ثقافته الفلسفية اليونانية وخاصة منها الفلسفة الأفلاطونية المحدثة؛ وكذا محاولة موسى بن ميمون (600 ه) في وقت متأخر قراءة وتأويل نفس النص التوراتي لذات الغرضـ في ضوء ثقافته الإسلامية، وخاصة في ضوء الفلسفة الرشدية... وذلك وأمثاله يجب أن يُعد إسقاطاً يعكس هموم القارئ المؤول ولا يعكس حقيقة النص التوراتي الذي تَمّ الرجوع إليه.
ولعل أوضح من ذلك كله ما تعرض له التراث الصوفي الإسلامي من محاولات السطو عليه جملة وإعادة إدراجه ضمن التراث الديني اليهودي من طرف أعلام اليهود و«القبّال» اليهودية أواخر القرون الوسطى وبدايات عصر النهضة بأوروبا، كما هو حاصل بالنسبة لموسى اللّيوني (ق. 13 م) في قشتالة مع تراث ابن عربي([1])، ومع مؤلّف كتاب "الهداية إلى فرائض القلوب..." للربّى يحيى بن يوسف بن باقودا السرقسطي (ق. 11 م)([2]) الذي صاغ كتابه المذكور في الجملة اعتماداً على كتاب "إحياء علوم الدين" للغزالي، بعد أن جرّد وحذف منه أغلب الشواهد والنماذج الإسلامية وحشّاه بشواهد توراتية، فجاء كتابه يهودي الشكل، إسلامي الجوهر، عربي اللغة! وبالمناسبة فقد سبق للفقيه ابن عبدون الإشبيلي (ق. 11 م) في كتابه "الحسبة" أن دعى إلى عدم بيع كتب علوم الإسلام إلى اليهود والنصارى لكونهم، على حدّ قوله، يقومون بترجمتها ثم ينحلونها وينسبونها لأحبارهم وأساقفتهم([3])..!
لأجل ذلك وجب الحذر من كل أشكال الخلط بين أصل الدين وكلياته ومبادئه الأساس وبين تأويلات المتلقين له، خاصة منهم الغافلون عن سياق النصوص وضوابط فهمها، كما حصل بالنسبة لبعض فقهاء الإسلام الذين أفرطوا مثلاً في توظيف مفهوم «النسخ» لإسقاط كليات قرآنية ثابتة مراعاة فقط لظروفهم الاجتماعية الخاصة ولأوضاعهم السياسية النسبية([4]). ونفس الأمر ينطبق في وقتنا الحاضر على جل ما يسمى «بالحركات الإسلامية» والتي يجب أن ندرك أنها في الجوهر حركات سياسية، تلجأ إلى الإسلام غالباً لتبرير مواقفها السياسية الخاصة، فهو تبرير سياسي، وليس بالضرورة تبريراً علمياُ ينطبق على مضمون النص الإسلامي...
لذا ومراعاة لتلك الضوابط، سنحاول من جهتنا أن نبسط في هذه الورقة تلك المبادئ الأساس التي نرى أن الإسلام انطلاقاً من أصوله الكبرى قد أقام عليها بناءه الأخلاقي، وذلك في ضوء مقاربة تأسيسية تنظيرية. وإذا كان الفيلسوف إيمانويل كانط (E. KANT)، في مؤلفه الموسوم "بالمبادئ الأساسية لميتافيزيقا الأخلاق"([5]) قد حاول إقامة فلسفته الأخلاقية على جملة أسس ومبادئ كلية ميتافيزيقية عليا، فذلك لكون الوقوف على مثل تلك المبادئ والمفاهيم الكبرى كفيل بضبط كل إمكانات الإنسان الأخلاقية، وهو الذي يسمح بتقييم وترشيد مختلف مواقفه العملية...
ولذلك فلن نبسط اليوم في هذا البحث القضايا والإشكالات الأخلاقية الجزئية التفصيلية وتجلياتها في القرآن الكريم ونماذجها، سواء تمثلت في السيرة النبوية أو في المدونة الفقهية الأصولية والكلامية وخاصة المدونة السلوكية الصوفية، بقدر ما نسعى إلى التأكيد على أن أي حديث عن منظور الإسلام للمشكلة الأخلاقية لا يستقيم إلا بالحديث عن بنية هذا الإسلام ذاته وعن رؤيته للعالم ولمنزلة الإنسان في هذا العالم وعن الانعكاسات الممكنة لتلك البنية وهذه الرؤية على القيم الأخلاقية ذاتها...
1 - الإنسان، ذلك الكائن الأخلاقي
ليس هناك شك في أن الإنسان هو الكائن الأخلاقي الوحيد في هذا العالم، حتى أنه يجوز أن نستبدل التعريف الفلسفي التقليدي للإنسان أنه «حيوان عاقل» بتعريف بديل يرتكز على خاصية الخصائص التي لا يشترك فيها مع الإنسان كائن آخر، ألا وهي خاصية الأخلاق والمسؤولية الأخلاقية، مما يستوجب معه تعريف الإنسان بأنه «كائن أخلاقي»؛ أليس هو وحده من يتحمل تجربة المسؤولية وتجربة التمييز ثم الاختيار بين الخير والشر؟ أليس منوطاً بالعقل نفسه أن «يعقل» ويمنع الإنسان من النزول إلى درك البهيمية وحضيض الأنعام كي يرقى إلى رتبة القيم الأخلاقية التي تصير وحدها علامة على «إنسانية» صاحبها؟
ذلك ما يجعلنا نؤكد أن أبرز ما يميِّز الفعل الإنساني عن مرتبة السلوك الحيواني، قدرة الإنسان على تحويل الطبيعة إلى «ثقافة» وقيم فكرية اعتُبرت دوماً أساساً في التمييز والفصل بين المرتبة الحيوانية الدنيا ومراتب الخلق الحضاري الإنساني؛ الأمر الذي يجعل من النشاط العملي والممارسة الإنسانية ليس مجرد «سلوك» خاضع لقوانين الطبيعة وللفعل وردّ الفعل وللإشباع الغريزي، بل إنه سلوك يرقى إلى مستوى العمل (L’action) بفضل تلك القدرة التي يتفرد بها الإنسان؛ عمل أو ممارسة تستهدف خلق نظام من المعارف والقيم الحضارية، أي نظام من المقاصد الأخلاقية الضابطة لذلك العمل والسلوك الإنساني. من ثَمّ وجب اعتبار الممارسة الأخلاقية تتويجاً للعمل وللتجربة الإنسانية، وتمييزاً فاصلاً بين هذه التجربة وبين حضيض المرتبة الحيوانية. وعلى حد قول الفيلسوف أبى الحسن العامري (381 ه.) «العلم بداية العمل، والعمل تمام العلم»([6]). ولذا لا يمكننا إلا أن نؤكد مع فيلسوف المنطق والأخلاق طه عبد الرحمن أن «الأخلاقية هي وحدها التي تجعل أفق الإنسان مستقلاً عن أفق البهيمية [...] والعقلانية التي تستحق أن تُنسب إليه ينبغي أن تكون تابعة لهذا الأصل الأخلاقي»([7]) وهو أصل مترسخ في تاريخ البشرية الأولى ترسخ الدين وأنماط التديّن الذي عُرف لدى الإنسان منذ القدم...
وعليه فقد تقرر أن السلوك الأخلاقي قرينٌ بالمعتقد الديني حتى في صورته البدائية، مما ينهض دليلاً على استحالة فصل الأخلاق عن الدين جملة؛ فقد تجد مذاهب فلسفية أو فكرية لا تعير اهتماماً لضوابط السلوك الأخلاقي، ولكنك لن تقع على دين يخلو من قيم أخلاقية يعتبرها شرطاً للانتساب إليه والوفاء بمبادئه؛ وذلك ينهض دليلاً على جدلية العلاقة بين الدين والأخلاق وبالتالي على تبعية الأخلاق للدين؛ وإذا كان مفاد هذه التبعية أن الدين حتماً ليس هو العامل الأول ولا بالعامل الأساس في قيام الحضارات الإنسانية الأولى؛ إلا أنه في خضم تلك الحضارات كان الدين بتجلياته المختلفة يحضر دوماً كموجّه أساس وكعامل فعال لضبط وتقويم وتوجيه مختلف أنشطة الإنسان الفردية والجماعية...
والملاحظ أنه حتى الذين تعمدوا في مطلع العصر الحديث بالغرب، فصل الأخلاق عن الدين، قد انتهت بهم هذه المحاولات إلى ابتداع أخلاق مستقاة أصلاً من قيم ومفاهيم دينية سابقة، وتلبس لبوساً دينياً متنكراً، سواء صرحوا بذلك أم أخفوه؛ كما حاول ذلك كلٌّ من كانط (Kant) وأوجيست كونت (August Comte) وأمثالهما من المنظِّرين الأوائل للفكر العلماني...([8]) وبذلك يتأكد أن «لا دين بغير أخلاق، ولا أخلاق بغير دين»([9]) خصوصاً إذا علمنا أن الدين في جوهره لا يفصل بين الشعائر والممارسات الظاهرة وبين الثمار النفسية والآثار الْخُلقية المعلّقة على تلك الشعائر «إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر»([10]).
وإذ نشدد هنا على أهمية الوصل بين الدين والأخلاق في تاريخ الفكر الإنساني إلا أن هذا الوصل أو الارتباط لا يأخذ معناه إلا بضرورة الاقتناع بحاجة الإنسان وتطلعه إلى تقييم عادلٍ لأفعاله، لا ظلم فيه ولا حيف؛ إذ في غياب هذا التقييم العادل والإنصاف الكامل تفقد حياة الإنسان معناها، ويصبح جهاده الأخلاقي بل يصير وجوده كله عبثاً لا حكمة وراءه، ما دام التمييز يظل معطلاً وميئوساً منه ما بين المحسن والمسيء، والعادل والظالم، والخيِّر والشرّير، وما دام الفناء يطال كل شيء، فيتساوى الإنسان والحيوان في المصير إلى محض تراب تذروه الرياح، لا أكثر ولا أقل من ذلك... فما أغنى الإنسان عن خوض العقبة الكأداء، عقبة القيم والأخلاق وجهاد النّفس، فذلك هو عين العبث واللاّمعنى. ولم تنفع هنا محاولة كانط إقامة منظومته الأخلاقية بعيداً عن الدين وتأسيسها، فحسب على «مفهوم الواجب الأخلاقي» و«الإرادة الطيبة»، فظل مشروعه مشروعاً مثالياً أعقبته مباشرة فلسفات «شوبنهور» و«نيتشه» وأمثالهما من الرؤى المأساوية للحياة تُلقي بالإنسان في أتون اليأس واللاّمعنى...
اتّقاءً من هذا الفكر العدمي، كان تشديد الأديان على أهمية الإيمان باليوم الآخر، كمحطة أخيرة ضرورية لتقييم أعمال كل إنسان مرّ بتجربة الحياة هذه؛ ولعل القرآن الكريم، من بين الكتب الدينية، كان أكثر عناية بإبراز القيمة الأخلاقية لمحاسبة ومسائلة كل إنسان إنسان على كل صغيرة أو كبيرة مما أتاه من أفعال ومواقف أخلاقية في حياته؛ وهي محاسبة جديرة أن تجعل الإنسان يرتدّ إلى باطن ذاته ويشعر بمبلغ الأمانة التي تحمّلها، أمانة المسؤولية الأخلاقية التي وحدها ترفعه عن حضيض الحيوانية وتضفي على حياته «معنى» معقولاً؛ والآيات القرآنية العديدة بصدد تلك المحاسبة شديدة الواقع على كل إنسان يبحث عن هذا المعنى، خاصة حينما يدرك أن لا شيء من أفعاله وحركاته ونواياه يندّ عن الحصر؛ بل تُسَجَّل كل صغيرة وكبيرة في كتاب يلقاه منشوراً يقرأه بنفسه! ويُعرض ذلك كله على موازين القسط والعدل الذي لا ظلم فيه ولا محاباة([11])...
2 - الأخلاق وتجديد الرؤية
بعد توضيحنا لمنزلة الأخلاق في تشكيل هوية الإنسان ككائن متفرد في هذا العالم وبعد إشارتنا إلى شدة الارتباط بين القيم الأخلاقية وأنماط التدين في تاريخ المجتمعات الإنسانية، وجب علينا بالتبعية بيان كيف أن هذه القيم في الأديان نفسها تتفاوت وتتفاضل درجاتها في الإحكام والشمول بحسب مستوى المشروع الإصلاحي الذي تحمله وتبشر به، سواء على المستوى العقدي والفكري، أو على المستوى العملي في تجلياته الاجتماعية والسياسية... بما يعني أن قيمة المشروع الذي يحمله دين من الأديان تابعة بالضرورة إلى نوع «الرؤية» للعالم وللإنسان التي يحملها ذلك الدين؛ تلك الرؤية التي تتجلى بالضرورة في جملة مبادئ وقيم أخلاقية تؤثث نظرياً النصوص الأساس للدين وتتجلى عملياً في «نماذج» إنسانية تحاول تنزيل تلك القيم على أرض الواقع؛ ومن ثَمّ ليس جائزاً أن ننسب إلى دينٍ ما قيماً أخلاقية معينة إلا إذا كانت هذه القيم منسجمة مع فلسفة ذلك الدين ومعبرة عن جوهر رؤيته للعالم وللإنسان.
بعد تشديدنا على هذه الملاحظة المنهجية يمكننا القول بأن بناء أية منظومة أخلاقية في أيّ مجتمع يقتضي البدء أولاً بإقامة نوع من «السِّلم» بين الفرد وبين نفسه يجعله يشعر «بانسجام» مع ذاته ومع محيطه الإنساني والطبيعي ومع تطلعاته الروحية كذلك. ولقد نجح الإسلام بعيداً في خلق هذه «الجسور» الواصلة بين الفرد والعالم، وبينه وبين الله، وبينه وبين باقي البشر، موافقين له كانوا أم مخالفين. وهنا تبرز لنا أهمية الجسور التي يقيمها القرآن بينه وبين الأديان الكتابية قبله، باعتبار انتماء الجميع في الأصل إلى دين واحد، يجمع كل الأنبياء الذين هم «إخوة لعلاّت أمهاتهم شتى ودينهم واحد» كما ورد في حديث نبوي وفي ذلك ما يمهِّد تمهيداً طيباً لإقامة سلام بين أهل الأديان الكتابية بخاصة.
غير أن إقرار القرآن بهذه الصلة بينه وبين التجارب الدينية السابقة عليه لا ينفصل لديه عن مراجعةٍ نقدية تقويمية إيجابية لتلك التجارب الدينية، مراجعة تطمح إلى التكميل والبناء، وليس إلى التقويض والهدم، أدت به إلى تقديم رؤية نقدية لروح الدين، أحدثت تغييراً كبيراً واختلافاً ملحوظاً مع جملة تصورات في تلك التجارب الدينية القديمة والتي اعتبرها الإسلام، في أفضل الأحوال، تصورات نسبية ووقتية انتهى مضمونها بانتهاء مرحلتها، خاصة فيما استقرت عليه التجربتان الدينيتان السابقتان من أن العالم سيظل دوماً في حاجة إلى نبوة جديدة، وأن الإنسان لم ينضج بعد، وأنه لذلك سيظل دوماً ينتظر «الخلاص» من غيره في زمن لم يحن بعد موعده...
فهذه «رؤية إلى العالم» كمجال غير قابل للإصلاح الآن، ورؤية إلى الإنسان ككائن لم ينضج بعد لتحمل مسؤوليته الأخلاقية الفردية والجماعية، وأن عدم نضجه هذا يبقيه دوماً متطلعاً إلى «منقذ» يعيده من شتاته أو يخلّصه من هذا العالم الذي سقط إليه والذي أُرغم على العيش فيه... وكأن الدين في الحالتين لم يكتمل إلا بنزول وعودة ذلك «الإنسان الأخير» الذي لن يعرف العالم سلاماً قبل مجيئه بل إن مجيئه لن يتحقق إلا بعد حرب تسحق المخالفين وتنفيهم من الوجود... وظني أن ما روّجته في السنوات الماضية القريبة كلٌّ من أعمال (فوكوياما) و(هنتنغتون) حول نهاية التاريخ والإنسان الأخير. ليس إلا إعادة صياغة علمانية لنفس تلك الصورة الدينية الكارثية القديمة للعالم المشار إليها..!
ذلك جوهر الرؤية الدينية للعالم وللإنسان التي عاصرت ظهور الإسلام، مع ملاحظة أن الإسلام قد عاصر أيضاً تصورات أخرى للعالم، قائمة هي كذلك على «ثنائيات» متنافرة في الأساس، تنتهي إلى شعور الإنسان بنوع من التمزق والتردد بين عالمين متنافرين لا تواصل بينهما؛ فلقد كانت «الغنوصيات» الوارثة للفلسفة الهيلينيستية تقول باستحالة التواصل المباشر بين «عالم الكون وعالم الفساد» وأن الأمل الأقصى للإنسان هو السعي للخلاص من هذا العالم عن طريق أنواع من التأمل والرياضة الروحية، كما تمثّل ذلك في فلسفة أفلوطين وأضرابه... مثلما أن الفكر المانوي والزرادشتي قبله لم يكن يرى في العالم غير قوتين متحكمتين فيه، متصارعتين لا تهدأ الحرب بينهما، وتنعكس آثارهما على حياة الإنسان... وإنها لتصورات ومفاهيم عن الوجود والإنسان والطبيعة ما كان بإمكانها أن تمدّ الإنسان بنوع من الاطمئنان النفسي والإقناع العقلي والانسجام المطلوب بينه وبين العالم، فضلاً أن تُشعره بسلام حقيقي بينه وبين البشر([12])...
ورغبة في تحقيق ذلك الاطمئنان النفسي والإقناع العقلي والانسجام المطلوب بين الإنسان والعالم نلاحظ أن الخطاب القرآني، خلافاً لما كان سائداً في الكتب الدينية السابقة، حريص عند مراجعاته النقدية، على تقديم بدائله العقدية أو الأخلاقية مرفوقة بمختلف الأدلة والحجج رغبة في إقناع المخالف والمعارض في أسلوب حجاجي يبغي الإقناع ويندد بالتقليد والركون إلى الظن، ويعلي دائما من قيمة «الحق» وينبه إلى أهمية هذا العالم المحسوس لطلب الكمال الأخلاقي ولا يغض من قيمته كما كان دأب العديد من الأديان والمذاهب بما فيها المذاهب الفلسفية اليونانية. وعلى حق قول محمد إقبال: «إنه لأمر عظيم حقاً أن يوقظ القرآن تلك الروح التجريبية في عصرٍ كان يرفض عالم المرئيات [= الطبيعيات] بوصفه قليل الغَناء في بحث الإنسان وراء الخالق»([13]).
من ثَمّ وجب من الناحية العلمية، أن نقدر حق التقدير، ونتبيّن الأبعاد النظرية والعملية الأخلاقية لتلك المراجعات النقدية التي تحتل مساحة واسعة من القرآن لمثل تلك التصورات القديمة حول مفهوم العالم ومفهوم الإنسان ومفهوم الدين ومفهوم النبوة، مما كان له انعكاس ضروري على الجانب الأخلاقي، قيماً وسلوكاً. إضافة إلى توجّه رسالة الإسلام منذ يومها الأول إلى الإنسان من حيث هو «إنسان»؛ دون اعتبار لجنسه أو قبيلته([14])، ونقدها تبعاً لذلك «للمجتمع المغلق» وتبشيرها «بمجتمع مفتوح» وبقدرة الإنسان على تسخير الطبيعة والتحكم فيها، ورفضها الواضح لما اعتبرته تقييداً لطاقة الإنسان وتقلبه في هذا العالم، من قَبيل مفهوم «الخطيئة» الأصلية الموروثة والسقوط واللعنة الموروثة والرهبنة، واعتبار العالم عالماً «مدنّساً»؛ مع تشديد رسالة الإسلام على المسؤولية الأخلاقية لكل فرد من أفراد الإنسانية، واعتبار التنوع البشري، الجنسي أو اللغوي، آية من آيات القدرة الإلهية، وليس عقاباً أو لعنة كما ورد ذلك في «التوراة»... علاوة على دفاع الإسلام عن أصالة السلم ووجوب السعي إليه، ودفع العدوان وعدم الاعتداء على الغير المسالم، وتحبيذ التعايش مع الآخر المخالف وحتمية التعارف بين البشر... وغير ذلك من المفاهيم الأخلاقية التي تؤثت رؤية الإسلام للعالم الجديد والتي بفضلها يتحقق «السلم الداخلي» للإنسان الفرد، قبل أن ينعكس على باقي الناس وتترجمها أخلاقهم.
وبوقوفنا على بنية الإسلام وتبيُّننا لخطابه ومقاصده، لا نملك إلا أن نلاحظ ذلك الطموح الإسلامي لإقامة أخلاق تعمّ الإنسانية عامة، قائمة على الرحمة واليسر وإفشاء السلام وبذله بين كافة الناس؛ حيث يعلن القرآن صراحة القصد العام والبعيد من رسالة الإسلام حين مخاطبته للنبي r بالقول «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» (قرآن كريم: الأنبياء، 107) كما يحث المسلمين قبل غيرهم بقوله: «يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة» (قرآن: البقرة، 208). ولأجل ذلك نرى النبي r من جهته، ينبه إلى ذلك المقصد القرآني بكلام تأكيدي حصريّ بقوله: «إنما بُعِثت لأتمّم مكارم الأخلاق»، باعتبار هذه المكارم ليست من بُلغ السلوك وفضله وزيادته، بل باعتبار تلك المكارم أساس وجوهر الأخلاق ومقاصدها الكبرى([15]). ومن ثَمّ ندرك مغزى تشبيه الرسول لدوره في سلسلة تتابع الدعوات الدينية الكتابية «باللبنة» الأخيرة التي تُتمِّم وتكمِّل وتُتوِّج كل المشاريع الدينية الأخلاقية السابقة؛ ثم حرص الرسول أن ينبه أصحابه إلى القطع مع تلك «الأخلاق المغلقة» التي كانت سائدة في العالم القديم، خاصة بين أتباع الديانات؛ وذلك حينما انتصب قائماً عند مرور جنازة ليهودي، فاستغرب أصحابه لهذا الموقف ونبهوه إلى أنها جنازة «لرجل غير مسلم، بل هي ليهودي»، واليهود يومئذٍ متحالفون مع مشركي قريش ونقضوا «ميثاق المدينة»... ولكنه عليه السلام قال لهم منبهاً «أليست نفساً؟!» أي: أليست إنساناً مكرماً؟
بل إن تاريخ «أسباب النزول» يذكر أنه قد نزل وحْيٌ يُتلى إلى اليوم لإنصاف يهودي اتهمه مسلم ظلماً بالسرقة وسارع أهل المسلم إلى النبي r يدّعون جناية اليهودي، فما كان للرسول عليه السلام إلا أن يظن أن الحق معهم، فحامت الشبهة حول اليهودي... ثم نزل الوحي في تسع آيات متواصلة منبهاً الرسول r إلى براءة ذلك اليهودي وإلى عدم الركون إلى بعض «الخائنين» من المسلمين الخارجين عن الأخلاق... كل هذا في وقت كانت الجماعات اليهودية تكيد للإسلام وتتآمر عليه مع مشركي قريش([16]).
ذلك وأمثاله من المفاهيم النظرية والمواقف العملية الأخلاقية يجعلنا نؤكد أن تلك المراجعات التصحيحية البادية في القرآن إنما تعبر بوضوح عن قطيعة واضحة مع جملة تصورات عقدية قديمة وتصرفاته أخلاقية عملية تقليدية، ومن ثَمّ وجب علينا ألا نمرّ مرّ الكرام على تلك المفاهيم والقضايا التي قد يعتبرها البعض مجرد مفاهيم وقضايا «دينية» محضة، في حين أنها ذات حمولة معرفية جديدة تنعكس على جميع المواقف الأخلاقية وعلى وضعية الإنسان في هذا العالم([17]).
فمفهوم «التوحيد» مثلاً الذي لم يشدّد دين عليه مثلما شدَّد الإسلام، لم يكن مجرد مبدإ عقدي، بل إنه انطوى على قيم أخلاقية وإجراءات عملية؛ فعلاوة على أن مفهوم التوحيد يتضمن أن الله هو رب العالمين وأنه تعالى ليس إلهاً لشعب مختار، دون شعب، أو إله «خراف» قوم دون قوم... وإنما هو يتوجه بدينه بدعوته ومنذ يومه الأول «إلى جميع الأمم بدين واحد، وهداية واحدة، وإيمان واحد بإله واحد لا إله غيره، يتساوى الناس بين يديه ولا يتفاوتون بغير الفضل والصلاح»([18]). وليس غريباً أن يترجم أحد المستوعبين الأوائل من المسلمين لهذا البعد العملي والإنساني لمفهوم التوحيد بقوله: أن قصد رسالة الإسلام هو «إخراج كافة الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان، إلى عدل الإسلام»([19]).
وعلى غرار مفهوم التوحيد، نجد حضوراً واضحاً لمفهوم «ختم النبوة» كمفهوم إجرائي من الناحية الأخلاقية؛ فخلافاً لما كانت تعرفه وتعتاده الأزمنة ما قبل الإسلام من تتابع الأنبياء والرسل تترى، الواحد بعد الآخر، في عصور متلاحقة، بل وفي أوقات متزامنة ولأسباب وقتية ظرفية... يأتي الإسلام، برسالته الخاتمة، ليعلن بالأساس رفع الإصر والأغلال عن الإنسانية عامة في مرحلة نضجها بعد اختتام عصر أو مرحلة النبوات. وإنها لرؤية جديدة لمستقبل الإنسان، بل رؤية متفائلة بتقدم الإنسان وبلوغ رشده فيما سيتلو من تاريخ هذا الإنسان...
ولعلنا لا نعدو الصواب إذا قلنا إن المفكر والشاعر محمد إقبال يعتبر خير من عبَّر عن أبعاد ذلك الرشد الإنساني الذي بشر به الإسلام وذلك حينما عقَّب على قول أحد صوفية الإسلام: «صعد محمد النبي العربي إلى السماوات العُلَى ثم رجع إلى الأرض؛ قسماً بربي لو أني بلغت هذا المقام لما عدتُ أبداً»! فيعقِّب إقبال على هذا الموقف الصوفي قائلاً([20]): «... فالصوفي لا يريد الرجوع من «مقام الشهود» [...] أما رجعة النبي فهي رجعة مبدعة، إذ يعود ليشق طريقه في موكب الزمان ابتغاء التحكم في ضبط قوى التاريخ وتوجيهها على نحو ينشئ به عالماً من المثل العليا جديداً. «فمقام الشهود» عند الصوفي غاية تُقصد لذاتها؛ لكنه عند النبي يقظة لما في أعماقه من قوى سيكولوجية تهزّ الكون كله، وقد قدِّر لها أن تغير نظام العالم الإنساني تغييراً تاماً...». لأجل ذلك أصبح نبي الإسلام «يقوم بين العالم القديم والعالم الحديث، فهو من العالم القديم باعتبار مصدر رسالته؛ وهو من العالم الحديث باعتبار الروح التي انطوت عليها [...] إن إبطال الإسلام للرهبنة ووراثة الملك ومناشدة القرآن للعقل وللتجربة على الدوام، وإصراره على أن النظر في الكون والوقوف على أخبار الأولين من مصادر المعرفة الإنسانية؛ كل ذلك صور مختلفة لفكرة انتهاء النبوة»([21]).
ثم يأتي التاريخ، التاريخ الإنساني العام، المعروف لدينا اليوم، ليزكي ذلك الإعلان القرآني بانتهاء عهد النبوات، حيث بدأ العالم، مباشرة بعد مجيء الإسلام، يعرف تغيراً عميقاً أدى بسرعة مذهلة إلى تقدم حضاري فكري واجتماعي شهدته الإنسانية وأدى التدافع بين المسلمين والعالم الآخر غربي وآسيوي إلى ازدهار فكري وتواصل حضاري، أصبحت الإنسانية فيه تعرف طوراً جديداً وانقلاباً عميقاً، لم تعد تجدي فيه تلك الدعوات النبوية القديمة، بل صار بإمكان هذا العصر الجديد أن يطلع على القيم والمبادئ الأخلاقية ويقارن بينها، ويدرك الحق ويميزه عن الباطل، معتمداً على قدراته العقلية التي بلغت درجة من الرشد والنضج المعرفي، ومسترشداً بالأديان والدعوات النبوية التي أكد الإسلام أنه جاء بخلاصاتها ومبادئها الكلية، وقد اعترف المؤرخ المعاصر ألبرت حوراني بطبيعة ذلك التغيير الذي أحدثه مجيء الإسلام إلى العالم بقوله بأن «كل الشعوب المعروفة قد استيقظت أو دخلت في التاريخ عبر اتصالٍ ما بالإسلام» من الهند إلى مجاهل إفريقيا إلى روسيا وأوروبا...
تلك شهادة التاريخ على ذلك الإعلان القرآني بأن عهداً جديداً قد فتح أمام الإنسانية بعد مجيء الإسلام... وكل تجاهل لهذه الحقيقة التاريخية أو تَعامٍ عنها، أو أية دعوة بانتظار «مُخَلِّصٍ» ما للإنسانية من الوحل، وأن موعده لم يحن بعد، إنما هو نوع من الارتداد بالإنسانية إلى الوراء! ولعل ذلك ما اقتضى من الإسلام أيضاً أن يعتبر الإنسان، مطلق الإنسان، «خليفة»، وأن نزوله إلى هذا العالم «كان نزوله كرامة، لا نزول إهانة» على حدّ قول الصوفي الكبير أبي الحسن الشاذلي. وبالتالي لا مبرر، ولا مجال للقول بأية نظرية عن «السقوط» أو أن الإنسان «ملقىً به في هذا العالم» دون سند ودون عناية. وبالتبعية لا مبرر أيضاً لدعاوى «التعجيل بالرحيل» والتبخيس من زينة الحياة والإقبال عليها أو الزعم بأن هذا العالم «مدنّس» وأن العالم الآخر هو وحده «المقدس»؛ فهذه ثنائية تمزق حياة الإنسان ولم يأت الإسلام إلا لتخليص الإنسان منها.
وهكذا، وبخلاف مفهوم أو عقيدة «الصراع الأبدي» الذي كان قائماً في الفلسفة الإغريقية وأساطيرها بين الإنسان والآلهة، وبين الإنسان والطبيعة؛ وبخلاف واقع النفور وعدم الانسجام الذي كان بين الإنسان و«عالم الفساد» الذي سقط إليه ويستعجل دوماَ مغادرته... بخلاف هذا وذاك، فإن الإسلام استبدل مفهوم الصراع ودعوى عدم الانسجام بمفهومي الاستخلاف والتسخير، وهما مفهومان أخلاقيان في غاية الأهمية؛ حيث يُثبت «الاستخلاف» لمطلق الإنسان الشعور بالكرامة والامتياز، مثلما يبعث فيه مفهوم «التسخير» شعوراً بالانسجام والاطمئنان والارتياح بينه وبين عالمه الطبيعي الذي يحيط به. وكيف يمكن تحقيق كل ذلك إن لم يؤسَّس على المبدأ الأخلاقي الكبير ألا وهو الإقرار بالمسؤولية الفردية ونقد مختلف التصورات الأخلاقية القديمة، الصريحة أو المبطّنة، والتي كانت تكبل إرادة الفرد وتلغيها بالمرة، إما بدعوى مسايرة سلطة الأعراف القبلية أو بدعوى وراثة الخطيئة أو بدعوى وراثة اللعنة الأبوية... في حين لا قيام لأخلاق إنسانية في تصور الإسلام إلا على مبدإ «ولا تزر وازرة وزر أخرى» (قرآن: الأنعام، 164) «وأن ليس للإنسان إلا ما سعى» (النجم، 29) و«كل امرئ بمن كسب رهين» (الطور، 21) «وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه» (الإسراء، 13) إلى غير ذلك من الصيغ القرآنية وضمنها العديد من الأحاديث النبوية التي تشدد على المسؤولية الفردية، مما اعتُبر فتحاً جديداً من «فتوح الضمير [الأخلاقي] في جميع مراحل التاريخ؛ إذ لا قيام للخُلق وللدين بغير التبعة، ولا معنى بغير التبعة لتكليف ولا حساب»([22]) وعلى حد قول المفكر نظمي لوقا وهو يشير إلى هذا الفتح الأخلاقي في الإسلام: «والحق أنه لا يمكن أن يقدر قيمة عقيدة خالية من أعباء «الخطيئة الأولى» إلا من نشأ في ظلّ تلك الفكرة القاتمة التي تصبغ بصبغة الخجل والتأثّم كل أفعال المرء، فيمضي في حياته مضى المريب المتردد... إن تلك الفكرة القاسية تسمم ينابيع الحياة كلها. ورفعها عن كاهل الإنسان منة عظمى، بمثابة نفخ نسمة حياة جديدة فيه؛ بل هو ولادة جديدة حقاً وردّ اعتبارٍ لا شك فيه؛ إنه تمزيق صحيفة السوابق ووضع زمان كل إنسان بيده»([23]).
3 - القيم الأخلاقية وإشاعة المعرفة
هذا وإن مسيرتا الفكر الإسلامي والحضارة الإسلامية عموماً دالتان على محاولات جمهور المسلمين غالباً معانقة وتنزيل واستثمار مختلف الآثار المباشرة التي ولّدتها تلك الرؤية أو ذلك الإصلاح الذي رام الإسلام التأسيس له عبر مفاهيمه الكبرى وتصوراته الكلية، هذه المفاهيم والتصورات التي بقدر ما أدت إلى إيجاد الشروط الضرورية لإقامة منظومة أخلاقية يتوّجها سلم شامل يسع كافة الناس، بأجناسهم وطوائفهم؛ فإن الأمن المتولد عن ذلك السلم هو الذي مهد الأرضية المناسبة لازدهار المعرفة ثم ساعد على إشاعة تلك القيم الأخلاقية في ظل حضارة الإسلام وعلى حد قول أحد مؤرخي العلم في الإسلام «لا يمكن دراسة العلوم الإسلامية [ذاتها] دراسة جدية من غير إشارة، مهما كانت موجزة، إلى مبادئ الإسلام والشروط التي أوجدها الإسلام في الزمان والمكان للاشتغال بالعلوم»([24])، وإذا أمكن لنا التمثيل لهذه الآثار المباشرة وغير المباشرة التي أوجدها الإسلام في باب القيم المعرفية والأخلاقية، يمكننا ملاحظة تلك القيم العلمية الكبرى التي يشيد بها مثلاً الحسن بن الهيثم (430 ه) في كتابه الشكوك على بطليموس حيث يشدد على قيم الحق والصدق وإنصاف المخالف والانتصاف من النفس، ونبذ التقليد واعتماد الاستدلال والبرهان... كما لا نخطئ الحضور القوي والواضح لقيم القرآن هذه ونظرته إلى العالم في مقدمة ابن خلدون المليئة بالمصطلح القرآني في باب الاعتبار بسنن الله الثابتة في الخلق...
غير أن كلامنا هذا عن مثل هذه القيم الأخلاقية المعرفية يجعلنا نلاحظ أمراً في غاية الأهمية وهو المتعلق بالفرق بين «نشر المعرفة» وإشاعة القيم الأخلاقية المرتبطة بها كما كان ذلك معروفاً داخل الأنظمة والتقاليد الدينية القديمة وما ابتدعه الإسلام من طرق جديدة في هذا السبيل: «فالمعرفة» في التقليد اليهودي مثلاً، خاصة منها المعرفة الدينية، غير قابلة للتداول؛ ولذلك ظلت محصورة بين طبقة الأحبار من الهارونيين، فنصوص التوراة لا يطلع عليها بل ولا يتلوها غالباً إلا الأحبار... وكذلك يقال بالنسبة للمعرفة في التقاليد الدينية داخل البيئة المسيحية، فلطالما ظلت المعرفة الدينية محتكرة بين الرهبان وداخل أسوار الأديرة خاصة...
في حين أن المسجد المفتوح للعموم في الإسلام ومكانه دائماً وسط المدينة قد جُعل محلاً لبذل العلم والمعرفة لطالبهما، وللمتردِّد على المسجد من أية فئة اجتماعية كان، كما لاحظ ذلك ابن خلدون عندما أكد أن «أغلب حاملي العلم في الإسلام الموالي»([25]) وقد صار العلم بالنسبة لهم وسيلة للارتقاء الاجتماعي... علاوة على أن من شأن هذه السهولة أو القرب في بذل العلم ونشر المعرفة أن تشيع بين الناس القيم الأخلاقية والمبادئ الفكرية التي من شأنها أن تساعد على العيش المشترك، مثلما تغري الجمهور العريض من الناس بالتمسك بتلك القيم والمطالبة بتنزيلها إذا ما افتقدوها في واقعهم اليومي يساعدهم في ذلك ما تقرر في دينهم من وجوب «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وهو مبدأ لا تخفى أبعاده الأخلاقية على المستوى الفردي والجماعي([26]).
ومن ثَمّ كانت إشاعة المعرفة في الإسلام تتعارض تماماً مع أيّ ادعاء باحتكار المعرفة بدعوى «القداسة»، قداسة كتابٍ ما، أو بدعوى الامتياز العقلي أو الإصطفاء العرقي، كما عند أفلاطون الذي كتب على باب أكاديميته «من لم يكن رياضياً فلا يدخل علينا»! أو كما فعل أرسطو الذي جعل التفكير الفلسفي أو المعرفة العلمية موقوفة على أهل أثينا، دون باقي البشر والبرابرة، وخاصة دون النساء والعبيد الذين هم مجرد «آلات حية» على حد قوله!
4 - القيم الأخلاقية وحق الاختلاف
ليس بالإمكان الحديث عن منزلة الأخلاق في أي دين أو مذهب فلسفي وفكري دون إثارة مشكلة الاختلاف وقضية الأقليات؛ فهي بالأساس مشكلة أخلاقية قبل كل شيء. وواضح أن ذلك التصحيح الذي أكدنا عليه سابقاً والذي رام الإسلام أن يضطلع به، سواء على مستوى المفاهيم والتصورات أو على مستوى التنزيل والممارسات، قد فرض عليه أن يطرح بحدة مشكلة الاختلاف ويوضح موقفه من الآخر بكيفية تختلف جذرياً عما كان متداولاً حول هذه المشكلة في العالم القديم وفي الممارسات الدينية السابقة عليه. والملاحظ بهذا الصدد أن القرآن يقر مبدئياً بواقع «الاختلاف» باعتباره ظاهرة إنسانية طبيعية، تقتضي حسن التدبير، ولا تحتمل الإكراه ولا التدمير؛ بل إن الاختلاف يُشاد به في القرآن باعتباره تجلٍّ من تجليات الحياة الإنسانية السويّة، وحيث ذلك فقد حرص القرآن أن يتوجه بالخطاب أحياناً كثيرة إلى الناس كافة، داعياً إياهم إلى تبادل المصالح والمنافع، منبهاً بوجه خاص إلى أن التنوع والاختلاف بين البشر ليس مبرراً للتنافر والتناحر، بل هو بالأولى حافز لهم على التقارب والتعارف والتعاون؛ بل إن هذا التعارف والمتبادل يمثل قصداً إيجابياً وأساساً من مقاصد الوجود الإنساني. ولأجل هذا نجد القرآن يعتبر الاختلاف بين الناس في اللغة واللون آية إلهية دالة على رحمته الواسعة، وذلك بخلاف ما نجده في «سفر التكوين» من التوراة والذي يعتبر الاختلاف اللغوي بين البشر عقاباً بل مكيدة من الربّ للحيلولة دون تعارفهم وتعاونهم([27])!
وارتباطاً بمشكل الاختلاف، يلاحظ كل متصفح للقرآن الكريم ولمواقف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن «الإسلام في إقراره لحرية التدين يفرضها على المؤمنين به تكليفاً ويلزمهم بها اتجاه غيرهم، ديناً وعقيدة وسلوكاً، لا لمجرد التسامح أو المجاملة والمسالمة»([28]). ولذلك فعلاوة على المبدأ الكبير الذي رفعه الإسلام في التعامل مع المخالف والذي مفاده أن «لا إكراه في الدين»([29])، فإن ضابط تنزيل هذا المبدأ العقدي هو ذلك المبدأ العملي الآخر الذي مفاده «لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين»([30]). فبموجب هذا المبدأ الأخلاقي، إن الكف عن العدوان العقدي، وهو من أخطر أشكال العنف، والكف عن العدوان السياسي، خاصة في أجلى صوره وهو الاستعمار والتهجير من الأرض، إن الكفّ عن ذلك العنف المزدوج كفيل بالسماح بإقامة جسور من الحوار المتكافئ بقصد التفاهم، وجسورٍ من السماحة([31]) والتعايش بقصد التساكن. وتلك هي أهداف ومقاصد التعارف الإنساني بالمصطلح القرآني }يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا{ (الحجرات، 12).
ودون الحديث عن أول تجربة إسلامية ناجحة في تدبير الاختلاف، كما شهدت بذلك «صحيفة المدينة» على العهد النبوي، فإن التاريخ الإنساني شاهد كيف أن الإسلام في تلك العصور الغارقة في الفتن الدينية والاحتقان الطائفي، قد نجح إلى حدٍّ بعيد في تدبير مشكلة الاختلاف؛ والشاهد على ذلك حضارة الإسلام التي ضمت تنوعاً فكرياً واجتماعياً وعرقياً وتعدداً في الملل والنحل؛ في الوقت الذي كانت المجتمعات الأخرى تبشر دوماً «بالمجتمع المغلق» الذي لم يكن يخلو من معانات فئاتٍ من الناس لمجرد اختلافهم عن الأغلبية عرقياً أو عقائدياً. ولعل وضعية اليهود في العالم القديم وطيلة القرون الوسطى دالة على ذلك حيث طاردتهم تهمة «قاتلي الرب» أينما حلوا!... في حين لم يشهد الفكر اليهودي، ديناً وأدباً، يقظة وازدهاراً، ولم يبلغ اليهود شأواً ومنزلة اجتماعية واقتصادية بل وسياسية إلا في ظل المجتمع الإسلامي وفي ظل مناخ السلم الذي ألزم الإسلام به أتباعه وحمّلهم مسؤولية حفظ حقوق الأقليات. وإن في بقاء واستمرار الأقليات الدينية في المجتمعات المسلمة لدليل على فضل الإسلام في ذلك وعلى دعوته جميعاً ليتعارفوا... وقد أثر عن الخليفة علي بن أبي طالب قوله ناصحاً لسامعه: «الناس صنفان: إما أخٌ لك في الدين أو نظير لك في الخلق».
والواقع أن هذا التعامل الإيجابي مع ظاهرة الاختلاف ومشكلة الأقليات، قد سبق التأسيس له مبكراً في الإسلام؛ فعلاوة على ما مرّ بنا بشأن ذلك في القرآن الكريم، نلاحظ أن رسول الله r قد حرص وهو يبني المجتمع الجديد في المدينة، على كتابة «وثيقة المدينة» التي صارت بمثابة «دستور» وقانون عام ينظم حياة ساكني هذا المجتمع الجديد؛ وذلك برهان على كونه r قد دشن بهذا الإجراء عرفاً جديداً قطع مع النظام القبلي البدائي القائم على العصبية القبلية، بل قطع مع الأنظمة السياسية المعهودة في عصره داخل الحكم البيزنطي والساساني... وإذا كنا على علم تام بأن الجماعات اليهودية في ظل الحكم الإمبراطوري لهاتين الدولتين ظلت جماعات منبوذة ومحاصرة، فإن «صحيفة المدينة» تحرص أن تقف موقف المساواة من كل فآت أو «أهل هذه الصحيفة» بمن فيهم اليهود، «فإن لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وأثم» و«إن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وأن بينهم النصح والنصيحة والبرّ دون الاثم...»([32]) ولعل استمرار وبقاء روح صحيفة المدينة هو ما جعل ابن حزم الظاهري يضع افتراضه الأخلاقي الآتي: «إن من كان في «الذمة» وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه، وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالكراع والسلاح ونموت دون ذلك، صوناً لمن هو في ذمة الله تعالى وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإن تسليمه دون ذلك إهمال لعقد «الذمة»»؛ وها هو ابن تيمية يذهب ليفاوض المغول في شأن إطلاق الأسرى، وحين يبدي القائد المغولي رغبة في إطلاق الأسرى المسلمين دون غيرهم من النصارى يعترض ابن تيمية على ذلك قائلاً: «كل من عندكم هم يهود ونصارى، وهم من ذمتنا؛ ولهذا السبب نحن نفتديهم ولن نسمح لأي سجين، سواء كانوا من أهل ملتنا أو من أهل الذمّة أن يظلوا عندكم. وعند هذا [يضيف ابن تيمية] أطلق بإذن الله أولئك النصارى كما قدر الله، وكان هذا هو عملنا لوجه الله»([33]).
5 - إشكالية العلاقة بين القيم وأخلاق الحرب
ولعل ما يتعلق بمسألة الأقليات وبمشكلة تدبير الاختلاف، تلك المشكلة العويصة الأخرى، مشكلة الحرب وضوابطها الأخلاقية. فلأول مرة في التاريخ يدعو الإسلام أتباعه إلى وجوب الالتزام بضوابط أخلاقية إذا ما اضطروا إلى خوض الحرب ضد أيّ معتد؛ ويكفينا هنا الرجوع إلى «سفر التثنية» من التوراة لندرك كيف أن الحرب عند القدامى كانت بامتياز المناسبة التي يُشرَّع فيها دينياً «وأخلاقياً» خرق كل الضوابط الأخلاقية وإظهار أقصى الطبائع الحيوانية التي تصل إلى حد استئصال المخالف وحرق أرضه ومتاعه أحياناً، ولعل «سفر التثنية» نموذج دال على ذلك([34])... والواقع أن هذا النص الديني إنما يعكس معنى الحرب في المجتمعات والدول الإمبراطورية القديمة...
ومن العجب أن يأتي الإسلام في ظروفه القبلية والإمبراطورية والوثنية المعروفة ويحرص إذا ما اضطر إلى خوض حرب ما، أن يحيطها بمجموعة من الضوابط الأخلاقية الرادعة والتي ما كان يتعود سماعها المقاتلون الذاهبون إلى ساحة الوغى في العهود الماضية؛ وها هي وصية أول خليفة وحاكم لدولة الإسلام الفتية، أبو بكر الصديق، لقائد جيشه الذاهب إلى تخوم الشام بعد أن انتهى إلى علم المسلمين أن الروم يجيّشون أتباعهم ويعدّون العدة للإجهاز على دولة الإسلام في المدينة وفي الجزيرة العربية. يقول أبو بكر مخاطباً قائد جيشه: «... لا تخونوا، ولا تغلو، ولا تغدروا، ولا تمثّلوا، ولا تقتلوا طفلاً ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة، ولا تقطعوا نخلاً ولا تحرقوه، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً إلا لمأكلة؛ وسوف تمرون على قوم فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم لله...». والواقع أن هذا الموقف الأخلاقي الذي اتخذه أبو بكر مؤسَّسٌ على سيرة رسول الله r الذي اتخذ من «المعاهدات»بين الكيانات المتصارعة وسيلة ناجعة لإنهاء الحرب وإخماد نارها وإحلال السلام بينها([35]). ولم يتأخر رسول الله عن تثمين معاهدات الصّلح بين المتحاربين حتى لو كانوا من أديان وعقائد مخالفة؛ فقد ورد عنه قوله عما شهده قبل بعثته: «لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفاً ما أُحب أن لي به حُمْر النّعم. ولو أُدعى به في الإسلام لأجبت» وهو موقف يثمن فيه الرسول r هذا الحلف الذي تَمّ بين قوم مشركين، لكنه حلف إيجابي، باعتباره يكرس قيمة السّلم الذي يجب السعي إليه دائماً بين الناس كافة استجابة لنداء القرآن }يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السّلم كافة{ (قرآن، البقرة، 208). وهو صلى الله عليه وسلم إنما كان في ذلك يصدر هو الآخر عن تصور قرآني يعلي من شأن السلم ويدعو إلى إشاعة أخلاق التعاون والود بين المسلمين وغيرهم المختلفين عنهم ديناً ووطناً، وذلك انطلاقاً من قيم سبق الحديث عنها ووفقاً لمبدإ أساسي قوامه أنه «لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين»([36]). فبموجب هذا المبدإ فإن الكفّ عن العدوان العقدي، وهو من أخطر أشكال العنف والظلم، والكف عن العدوان السياسي، خاصة في أجلى صوره، وهو الاستعمار والتهجير من الأرض؛ إن الكف عن ذلك العنف كفيل بالسماح بإقامة جسور من الحوار المتكافئ بقصد التفاهم، وجسور من السماحة والتعايش بقصد التساكن. وتلك هي أهداف ومقاصد التعارف الإنساني بالمصطلح القرآني...
بل إن وقوفنا على سياق الآيات القرآنية التي ورد فيها مصطلح «الإرهاب» يوضح لنا بجلاء مدى رفض الإسلام لكل أشكال الاعتداء وحرصه على نسج علاقة مع الآخر قائمة على أولوية تثبيت السلم مع المخالفين؛ مثلما يوقفنا ذلك على مبلغ التناقض بين مفهوم الإرهاب في الاصطلاح القرآني ومعناه الذي صارت تلوكه الألسنة ووسائل الإعلام المعاصرة دون ضابط ولا مدلول قار، قبل أن ترمي به من شاءت من الخصوم والأعداء:
فبخصوص المصدر الإسلامي المشار إليه نجد الآيات الواردة في سورة الأنفال (25-62) والتي جاءت في الواقع لتعالج مواقف أولئك المخالفين للمسلمين عقائدياً وسياسيا كذلك، والذين يتقدم المسلمون إليهم بطلب عقد معاهدات الصلح والسلم، ثم يفاجأ المسلمون في كل مرة بنقض هؤلاء لعهودهم ومواثيقهم التي أعطوها والتزموا باحترامها! فهؤلاء إذن قد انتقلوا بإرادتهم من معاهدين إلى محاربين، ومن أصدقاء إلى أعداء... ومن ثَمّ يقتضي منا المنهج العلمي النظر إلى سياق تلك الآيات من سورة الأنفال كي ندرك موقف الإسلام من الحرب وندرك بالتالي الدلالة الحقيقية لمفهوم «الإرهاب» في سياقه القرآني والذي جاء تحديداً لمواجهة ذلك النوع من العدوان السياسي:
فقد ورد في هذه الآيات «إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون [= لا يحفظون عهودهم] فإما تثقفنهم في الحرب فشرّد بهم من خلفهم لعلهم يذّكرون [= يخشون عاقبة نقضهم المتكرر لمواثيقهم التي أبرموها مع المسلمين] وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم [...] وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمومنين».
إن أقل تأمل في سياق هذه الآيات يجعلنا ندرك أن مفهوم الإرهاب الوارد فيها إنما هو إرهابٌ لعدوٍّ دأب على التصريح بعدائه وإعداد العدة للهجوم والاعتداء ونقض عهود السلم... فالواجب في مثل هذه الحال الاستعداد لردّ هجومه كي لا يفكر في العودة إليه ويحسب له ألف حساب؛ ومن ثَمّ فطلب المسلمين للقوة ليس أبداً بنية الاعتداء ولا المبادرة بالحرب، ولكن بقصد ضمان احترام العهود والمواثيق وإقامة سلم دائم. لهذا خُتمت الآيات بالقول: «وإن جنحوا للسلم فاجنح لها» بما يعني: إن هؤلاء الذين تعودت منهم الخيانة ونقض العهود، إذا ما تبيّن لك، ولو من ظاهر أقوالهم وأحوالهم، أنهم عزموا أخيراً على احترام عهودهم وإقامة سلم معك، نأمرك أن تختار جانب السلم؛ وتوكل على الله ولا تتذرع بمواقفهم السابقة، إنه تعالى هو السميع العليم: السميع الآن لما يعطونك من عهودهم الجديدة، العليم بالنوايا والمقاصد؛ فأنت عليك أن تجنح لخيار السلم. أما لو عادوا إلى سابق عهدهم بالخيانة، فحتى إن وقع مثل هذا فإن حسبك الله، هو ناصرك عليهم...
ذلك هو القصد الحقيقي لطلب القوة والخيل، وإنه «إرهابٌ» لعدوّ متربص، لا بتجريده من سلاحه، ولكن بامتلاك قوة كافية لتحذيره وتنبيهه كي يقبل السلم ويجنح لها. فالمقصد من هذا الاستعداد إذن دفع ظلم وعنف الآخرين وإقامة سلم دائم، وليس شن الحرب... ذلك هو منطق الآيات القرآنية في التعامل مع المخالف وتلك جملة مبادئ وقيم كبرى لتدبير مشكلة الحرب وهي مبادئ وقيم أسَّس لها الإسلام لأول مرة بعد أن لم تكن معهودة في العالم القديم وهو ما مثّل فتحاً جديداً غير مسبوق في تاريخ العلاقات بين الأديان والدول جملة؛ ولذلك حق للمفكر الكبير محمد علال الفاسي، وهو ينظِّر لمقاصد الشريعة، أن يقول مراعياً لمقاصد الإسلام الكبرى، خاصة منها إفشاء السلم بين الناس، قال: «إذا قامت في العالم [اليوم] دعوة لتحريم الحرب جملة واتفقت دول العالم كلها بمقتضى أوفاق عامة مضمونة النفاذ؛ فإنه يجب علينا [كمسلمين] أن نكون في مقدمة المستجيبين لهذه الدعوة، ويحرم علينا شرعاً الدخول في حرب، كيفما كان نوعها، بشرط أن تكون هذه السلطة الدولية قادرة على حماية الطوائف والأديان والجماعات بنفوذها من كل اضطهاد»([37]).
تلك هي بعض الأسس النظرية العامة التي نرى أن الإسلام قد أقام عليها صرح بنائه الأخلاقي، وهي أسس إذا كانت قد عرفت محاولات «لتنزيلها» على أرض الواقع عبر حقب وعصور حضارته الممتدة؛ إلا أن منطق التاريخ كان يحتِّم أن يطرأ على محاولات التنزيل تلك ما يطرأ عادة على كل تجربة بشرية من مظاهر التوفيق والنجاح أو عوامل القصور والفشل... والواقع أن مشكلة تنزيل قيم الإسلام عبر تاريخه الطويل مشكلة قائمة الذات، خصوصاً بالنسبة لتلك القيم المتعلقة بالتدبير السياسي. وإذا كان الوقت الآن لا يسمح لنا بتفصيل القول في هذا الموضوع الذي سبق أن خصصنا له كتابنا عن الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام، مثلما لا يسمح لنا الوقت أيضاً ببسط الكلام عن تجليات القيم الإسلامية كما مثلتها مختلف علوم الإسلام، من فقه وأصول وكلام وتصوف، أو كما عكستها اهتمامات المسلمين بموضوع الفنّ وتدبير المجال البيئي والطبيعي... فإني أضطر هنا إلى أن أسرد سرداً تلك القضايا الأخلاقية المتعلقة بهذه المجالات، ودون تفصيل وتدقيق:
أ - فمما لا شك فيه أن الفكر السياسي في الإسلام قد عرف ازدهاراً كبيراً خلال تاريخ الإسلام، إلا أن الملاحظ أن هذا الفكر، خاصة مع المتكلمين المعتزلة والأشاعرة، قد عرف غنى في التنظير، ولكنه كان يشكو من فقر كبير في محاولات التنزيل بسبب الحرص دائماً على إناطة التدبير السياسي بالأفراد وليس بالمؤسسات التي تدوم بدوام المجتمع ولا تنتهي بنهاية أو تغير الرجال...
ب - مقابل ذلك نجد المدونة الفقهية قد حاولت في الجملة تكريس الأخلاق الإسلامية خاصة في باب تقوية دور المجتمع في الاستقلال بتدبير شؤونه اليومية وتقليص دور الدولة في الاضطلاع بذلك... غير أن المدونة الفقهية نفسها كانت أحياناً كثيرة إنما تعكس ظروفاً اجتماعية خاصة وأحوالاً سياسية بل وقيماً أخرى قد تتعارض مع القيم الإسلامية أو لا تحرص على تحقيق مقاصدها. ولعل أوضح مثال على ذلك تلك «الشرعية» التي ما فتئت المدونة الفقهية تضفيها على «نظام الرّق» في العالم القديم، مسايرة من الفقهاء لمنطق رجل السلطة وللأنظمة السياسية والاقتصادية والحربية في ذلك العصر. في حين أن القرآن الكريم يبادر إلى إثارة موضوع الرق باعتباره مشكلة أخلاقية على المسلمين أن يسعوا إلى التخفيف منها في أفق إلغائها بالمرة، رغم كون «الرّق» كان إذ ذاك يعتبر «نظاماً دولياً» بل قد اعتُبر نظاماً «طبيعياً» عند أرسطو أو نظاماً «إلهياً» عند أوغسطين؛ في حين، وبخلاف ذلك التأويل الفلسفي وهذا التبرير اللاهوتي، وبخلاف ذلك النظام الاقتصادي السائد، فإن القرآن قد أرشد إلى وجوب تقليص كتلة الأرقاء في المجتمع الإسلامي، فسدّ أهم أبوابه وعمل على تسريع ذلك بربطه عتق الرقاب أحياناً كفارة عند أبسط الأخطاء وأكثرها وقوعاً في الحياة اليومية، معتبراً ذلك تعبداً وتقرباً إلى الله تعالى؛ وأحياناً دعا إلى المكاتبة الملزِمة بين الرقيق ومالكه الذي يصبح ملزَماً بتحرير ما تحت يده من رقيق...
ذلك أمر جديد في ذلك العصر، ولا يمكننا إلا أن نعتبره نزعة «تشوف إلى الحرية». وإذا كان المسلمون قد تنكبوا عن ذلك الإرشاد القرآني حول هذه الظاهرة الاجتماعية، فإن إبراز موقف القرآن منها ليعتبر اليوم واجباً علمياً ومسؤولية أخلاقية...
جـ - وبخلاف الفقه، فإن الحضور الأخلاقي واضح في مختلف الأعمال الأصولية؛ فقد شدد علماء الأصول على «معقولية التكليف» الأخلاقي ونددوا بالأوامر الاعتباطية وقعّدوا لمصادر التشريع بعيداً عن الأهواء والمصالح الشخصية خاصة منها مصالح رجل السلطة، وحاولوا إبراز المدونة التشريعية والأخلاقية إنطلاقاً من كليات ومقاصد معقولة تسمح للإنسان« بحق التقلب في العيش»، وقالوا بتوافق الشريعة مع الطبيعة انطلاقاً من مفهوم الفطرة التي باتت تعني منذ العز بن عبد السلام قديماً إلى ابن عاشور وعلال الفاسي حديثاً وجوب رفع الحرج وتمهيد كل السبل لمعانقة مكارم الأخلاق... وإذا كان هذا الفكر الأصولي قد ضمّ بمنطقه المعروف كبرى المذاهب الكلامية في الإسلام، إلا أن المعتزلة كانوا أكثر من غيرهم تشديداً على معقولية الخطاب الشرعي حين أقاموا أصولهم الخمسة المعروفة على «ميثاق أخلاقي» واضح يضفي المعقولية على مختلف الأوامر الشرعية...
د - وكيف يمكن الكلام عن «تنزيل» القيم الأخلاقية الإسلامية وحضور النموذج النبوي في التجربة الحضارية في الإسلام دون الإشارة إلى الدور الكبير الذي لعبه صوفية الإسلام في هذا المجال، وهو دور جعل الفكر الصوفي يعرف خصوصيات تميزه عن كل الأصناف الأخرى من الزهد المعروف قديماً. والواقع أن المفكر الصوفي كان قد فطن مبكراً إلى وجوب التمييز بين المظهر والجوهر في معانقته للقيم الأخلاقية. ولذلك أثر عن أوائل صوفية الإسلام عنايةٌ بالمقاصد ومراعاة للمآلات في كل ما يُقدمون عليه من أفعال، مع تأكيدهم على وجوب الانتباه إلى أعمال القلوب قبل العناية بأعمال الجوارح، كما لاحظ ذلك قديماً كلّ من الحارث المحاسبي (243 ه) خاصة في كتابه "العقل وفهم القرآن" والرعاية لحقوق الله، وكذا الحكيم الترمذي (296 ه؟) في عمله الموسوم بكتاب العلل. ولا شك أن أغلب صوفية الإسلام، خصوصاً منهم ذووا الاتجاه السني، ورغم مظاهر التقشف البادية عليهم، فد حرصوا على الالتزام بوسطية أخلاقية، بعيداً عن مختلف أنماط الرهبنة والابتعاد عن العالم؛ حتى صار التصوف يعني - كما يقول أحمد بن عجيبة - أن تكون الدنيا في يدك، لا في قلبك! بل ذلك ما جعل أحمد زروق الفاسي (899 ه) يختزل التصوف الذي عُرِّف بمآت التعاريف إلى تعريف واحد جامع يدل على جوهره ألا وهو «صدق التوجه» إلى الله في كل فعل أخلاقي؛ وصدق التوجه كأساس أخلاقي هو ما سيسميه الفيلسوف الألماني كانط (1804 م) بلغته العلمانية «الإرادة الطيبة»!
هذا ومما يمكن ذكره بخصوص الوعي بالمقاصد الأخلاقية ما أثر عن صوفي مغربي شهير في الدولة الموحدية وهو أبو العباس السبتي (601 ه) الذي بنى مذهبه الصوفي على الجود والعطاء وإغاثة المحتاجين ومشاطرته ماله معهم. وقد اشتهر أمره حتى وصلت أخباره إلى معاصره الفيلسوف الكبير ابن رشد (595 ه)، ربما حين قدومه إلى مراكش، حيث كان يقيم ذلك الصوفي؛ فأرسل من يأتيه بأخبار أبي العباس السّبتي، ثم اختصر مذهبه الصوفي بقوله: إن مذهب هذا الرجل قائم على اعتقاد أن الوجود ينفعل بالجود! والواقع أن العديد من التنظيمات الصوفية، بجانب نظام الوقف في المجتمعات الإسلامية القديمة، قد لعب دوراً اجتماعياً وأخلاقياً مهماً، ناب بل عوَّض في أحوال كثيرة ما كان يمكن أن تقوم به الدولة التي لم تكن دولة مركزية في غالب الأحيان، وذلك ما شكل نوعاً من «المجتمع المدني» الذي كان يقوم بأدوار مهمة شملت أحياناً رعاية الحيوانات وتدبير المواد الطبيعية...
ه - وعلى ذكر الطبيعة، فقد مر بنا من بين المفاهيم الإسلامية الكبرى بخصوص رؤية العالم، مفهوم «الاستخلاف» ومفهوم «التسخير» وهما مفهومان يحيلان إلى مشكلتين أخلاقيتين أساسيتين، مشكلة الفنّ ومشكلة البيئة: فلقد أدرك المسلمون جيداً رفض الإسلام لتلك الثنائيات المتنافرة: الدنيا والآخرة، المقدس والمدنّس، وأدركوا من القرآن نفسه، إمكانية الجمع بين الجمال والجلال، أو بين طلب الزينة والإقبال على الصلاة؛ وعلموا أن الإقبال على الدنيا بضوابط أخلاقية وقواعد سلوكية قد لا يتعارض مع الإقبال على الله واستحضار المآل في الآخرة... ولم يروا أن تناقض في الحديث النبوي «حُبب إليّ من دنياكم ثلاث: النساء، والطِّيب، وجُعلت قرة عيني في الصلاة» وبذلك صار طالب الجمال والإقبال على الجلال هو المعادلة الصعبة وهو القصد المطلوب من التخلق بالقيم... ولعل صوفية الإسلام كانوا أكثر دفاعاً عن هذا الجانب الجمالي من القيم الإسلامية.
ثم ليس بالإمكان أن نسترجع مفهومي الخلافة في العالم وتسخيره للإنسان، دون أن ننبه إلى الاختلاف الكبير بين الإسلام وغيره من الأديان والمذاهب، حتى منها المذاهب المعاصرة، حينما اعتبر هذا العالم الطبيعي «أمانة» مودعة لدى الإنسان، مأمور أن يتصرف فيها تصرفاً يحافظ عليها بما يليق ومسؤوليةُ الاستخلاف الذي تحمّله والذي يتضمن مراعاة القيم الكبرى وتنزيلها على الواقع ونشرها في محيطه الطبيعي والبشري... فالإنسان إذن «مؤتمن» على محيطه الطبيعي وليس مالكاً حقيقياً له، بل حتى ما امتلكه هذا الإنسان من مال وثروة، فهو «مال الله» لا يجب وضعه بيد السفيه المبذِّر، فلا محلّ في الإسلام لتلك القاعدة اللّيبرالية «دعه يمر، ودعه يعمل» كما تشاء (Laisser passer - laisser faire !) بل لابد من ترشيد كل نشاط إنساني في هذه الطبيعة، إذ كل عمل فيها هو قابل للتقويم الأخلاقي ومندرج إما في خانة «الصلاح» أو في خانة «الفساد» والله لا يحب الفساد: فقد دخل رجل الجنّة بإنقاذه لكلب عطشاناً؛ ودخلت إمرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها، ولا هي أرسلتها تأكل من حشيش الأرض، بل حتى البهيمة التي تحمل أثقال الإنسان حرص الرسول r أن يوصي صاحبها بعدم إجهادها وتعذيبها. وإذا كان الوضوء باستعمال الماء مطلوباً قبل الشروع في الصلاة فالتحذير واجب من الإفراط فيه والاقتصاد في ذلك مطلوب؛ وخلافاً لما أصبحت تعانيه بعض المجتمعات العربية المعاصرة بخصوص تبذير الطعام، لم يفت المنهج الوسطي في الإسلام أن يرشد المسلم إلى وجوب الانتباه إلى أن طعام الواحد قد يكفي الاثنين وطعام الاثنين قد يكفي الأربعة وهكذا، فلا مبرر لامتلاء القمامات بطعامٍ صالح والجوعى تمتلأ بهم الأرض...
لقد أدرك المسلمون قديماً ما تنطوي عليه أمثال هذه القيم الإسلامية في التعامل مع الطبيعة وأدرجوها ضمن خُلق «الرحمة» الشاملة للإنسان والحيوان، إذ «في كل ذي كبدٍ رَطْبٍ صدقة»؛ وقد عرفنا في مدينة فاس، خلال العصور الماضية وقفاً خصصه أصحابه لعلاج ما قد تتعرض له الطيور، خاصة منها طائر اللّقلاق الآوي إلى قمم صوامع المساجد، من أعطاب وأمراض، على غرار ما خصصوه للإنسان من بناء «بيمارستان» لمعالجة المرضى العقليين بوصلات موسيقية هادئة...
كل ذلك دال على مبلغ وأهمية المفاهيم والقيم الدينية والأخلاقية في صبغ الحضارات الناشئة عنها بصبغة خاصة، وقدرة تلك المفاهيم والقيم على توجيه الحياة الفردية والجماعية في أية حضارة؛ ولا شك أن نوعية تلك المفاهيم والقيم تابعة ومصطبغة بصبغة الإطار المرجعي الذي صدرت عنه. ولقد كانت قيم الإسلام الكبرى قيماً جامعة، فكانت عقلانية في طبيعتها، حوارية في منهجيتها، أخلاقية في مآلاتها ومقاصدها...
خاتمة
تلك إذن خصائص المشروع الأخلاقي الإسلامي، انطلاقا من نصوص أساس للإسلام ومن أعمال كبار منظريه القدامى والمحدثين؛ وهو بالجملة مشروع تحرير الإنسان من الإصر والأغلال الدينية والسياسية والاجتماعية؛ وذلك ما عكسته المساحة الواسعة التي خصها القرآن لنقد وتصحيح أهم المفاهيم والتجارب الدينية وأنماط الممارسات السياسية والاجتماعية؛ سواء تعلق الأمر بنقد النمط الديني لدى "أهل الكتاب" خاصة، أو النمط السياسي، حيث اتخذ القرآن غالبا من "فرعون مصر" نموذجا للاستبداد والطغيان السياسي؛ أو النمط الاقتصادي حيث يحضر "قارون" كنموذج للطغيان الاقتصادي؛ أو النمط الاجتماعي، كما تمثل ذلك في المتابعات النقدية للقرآن لعادات مشركي العرب وبدعهم العقائدية والأخلاقية...
غير أنه بالرغم من تلك المتابعات النقدية والتصحيحات لجملة مفاهيم عقدية وعلمية فإن الدارس للقرآن الكريم يلاحظ مع ذلك حرص القرآن على الوصول إلى " قواسم أخلاقية مشتركة" بينه وبين الأديان الكتابية الأخرى. وبهذا الصدد لاحظنا في العقود الماضية أصواتا ترتفع منادية إلى مساهمة أهل الأديان في إرساء قواعد "لسلام عالمي" وذلك عن طريق البدء بإيجاد قواسم أخلاقية مشتركة بين أديان العالم، بل دعت تلك الأصوات إلى إقامة "صلوات مشتركة" لذات الغرض... ! والذي أخشاه أن يكون القائمون على مثل هذه الدعوات عادوا يشبهون المذاهب "الغنوصية" في العالم القديم، تلك المذاهب القائمة على مجرد "التلفيق" éclectisme)) والجمع بين المتناقضات ونسف القيم الأخلاقية ذاتها، كما انتهى إلى ما يشبه ذلك ما يسمى "ببرلمان الأديان" في العصر الحديث...[38] والواقع أن العبرة ليست في مجرد الاعتراف بقيم عليا ومفاهيم نظرية كلية والتغني بها؛ إنما العبرة بتقديم رؤية متكاملة ومتضافرة لقيم صالحة للتنزيل على أرض الواقع ومساعدة للإنسان على التكيف والتقلب في العيش: فالبوذية مثلا وأمثالها من المذاهب والأديان ذات النزعة الداعية إلى ترويض الغرائز أو الهروب من العالم... تتضمن قيما، إلا أنها قيم تفتقر إلى تلك الرؤية الكلية التكاملية الضامنة لصلاحية تلك القيم على التنزيل والتي تمكن الإنسان من تمثلها وتنزيلها على ظروفه المختلفة...
وبالنسبة للأديان الكتابية، فقد أوضحنا سابقا كيف أن في اليهودية قيم أخلاقية، إلا أنها بالأساس قيم "مجتمع مغلق"... وإذا كانت قيم المسيحية جاءت كرد فعل لذلك التحجر في فهم ذات القيم التوراتية وكنقد لغفلة أحبارها عن مقاصدها، فإنها مثلت كذلك رد فعل متطرف في روحانيته ومثاليته ضد تطرف مقابل "لهذا بقيت [القيم] المسيحية في حقيقتها بين قلة من الأفراد ميسرين لها. وكانت نتيجتها المنطقية تلك "الرهبانية" المنعزلة عن الدنيا ومعاناتها"[39]. ولعل تجربة العنف الديني الطويل في بدايات العصر الحديث بأروبا وما شهدته هذه الأخيرة من حروب طاحنة بين الكاثوليك والبروتستانت هي التي جعلت أشهر المنظمين لما يسمى "ببرلمان الأديان والأخلاق العالمية"، القس الألماني "هانز كونغ" يلقي بالعاصمة الجزائرية سنة 1988 محاضرة بعنوان "لإسلام في العالم بدون الوئام بين الأديان"[40].
ومع يقيننا بأن الأديان ما كانت في الغالب سببا للحروب بقدر ما كانت مجرد غطاء إديولوجي وتبرير لدوافع أخرى سياسية واقتصادية وعرقية... إلا أن الإشكال الذي يعترضنا هنا بخصوص الدعاوى المعاصرة إلى البحث عن قيم مشتركة بين الأديان الكتابية خاصة، يتمثل في سؤالنا الإشكالي الآتي: كيف يجوز التأسيس للأخلاق انطلاقا من الإيمان بوجود "المشترك" بين تلك الأديان الكتابية، والحال أن كل دين سابق من تلك الأديان ينطلق من "مسلمة" تكذيبه للدين اللاحق ولا يعترف به ولا يدرجه في خانة الصدق؟! فإذا كان المؤسس للدين كاذبا وكذابا انهارت كل القيم الأخلاقية الممكن نسبتها إلى دينه! وبالتالي يصبح الانطلاق من مسلمة التكذيب نسفا لكل كلام عن "المشترك القيمي"؛ في حين هذا المشترك يمكن التأدى إليه بسهولة إذا ما انطلقنا من مبدأ "التصديق"، لا من مسلمة التكذيب؛ وتلك هي المشكلة التي نرى أن الإسلام قد تجاوزها وصار، بتصديقه بأصول الديانتين السابقتين عليه، مؤهلا أكثر من غيره لتقبل "المشترك القيمي" القائم على الاعتراف والإنصاف والدعوة إلى التعايش...
والواقع أن التعايش قد صار اليوم مطلبا مستعجلا لا يحتمل التأخير، بل إذا كانت الأخلاق جملة مما لا يحتمل التأجيل كما لاحظ ذلك (ديكارت) قديما، فإن إرساء اللبنات الأساس لتلك الأخلاق باتت في رأينا مشروطة بإيجاد "ميثاق" بين رجال الفكر من أي دين أو مذهب كان؛ إنه ميثاق مزدوج، لكونه يشمل البعدين الأساسيين للإنسان، البعد المعرفي والبعد العملي، ولا يند أحد منهما أن يكون موضع ميثاق أخلاقي:
- فالميثاق المعرفي يجب أن يضطلع به ويلتزم به أهل الاختصاص من الباحثين ورجال الفكر، يعلنون قطيعتهم مع الأحكام المسبقة واستعدادهم لاتخاذ أنجع الوسائل وأنسب الطرق والمناهج العلمية للبحث عن الحقيقة" والإصداع بها والتماس "الصدق" كقيمة عليا في مجال البحث العلمي... فهذا مشترك قيمي أخلاقي يجب أن يسود بين أهل الاختصاص الذين يعلنون بميثاقهم المعرفي هذا قطيعتهم مع الأحكام المسبقة ويعلون من قيمة "وجوب النظر"[41].
- في حين ينهض الميثاق العملي بتقويم السلوك الأخلاقي لكل إنسان، وهو ميثاق يشمل جملة قيم عملية مستعجلة لا تحتمل التأجيل بأية حال من الأحوال. وحتى لو بقي الاختلاف العقدي قائما، سواء بين الجمهور أو الخواص، فلا يجب أن يكون ذلك حائلا دون التوافق على قيم عملية مشتركة تتسم بروح الاعتدال والوسطية بعيدا عن كل أشكال الانغلاق والتشدد، وتستهدف تحقيق نوع من التعايش المساعد على "التعارف".
غير أن هذا التعارف وذلك التعايش يقتضيان جملة قيم ناظمة، يأتي على رأسها "حسن تدبير الاختلاف"، والقبول بالآخر، والتعاون على إقامة العدل وإنصاف المظلوم وإنقاذ المستضعفين والمضطهدين دينيا أو سياسيا، وكذا مواجهة كل المخططات العلمانية المتطرفة التي تركب بعض المفاهيم والقيم الأخلاقية لنسف الأخلاق ذاتها! كما هو حاصل بالنسبة لمفهوم "حقوق الإنسان" الذي صار من تداعياته المنحرفة" الدعوة إلى عدم تجريم الزنا الاختياري، بدعوى "حرية التصرف في الجسد"، والدعوة إلى "شرعية" الشذوذ الجنسي والزواج المثلى وحق الشواذ في تبني الأطفال وتكوين "العائلة"... ! وغير ذلك من الإجراءات التي تسعى إلى "عولمة الفساد الأخلاقي" والإجهاز على التماسك العائلي، خاصة في العالم الإسلامي؛ علاوة على العديد من التوظيفات المنحرفة لمفاهيم أخلاقية، تجعل أفق الإنسان ينتهي وينزل إلى أفق الحيوان في نشدان العراء التام والشهوة المطلقة... دون أن نتكلم عن خطورة سحب القيم الأخلاقية من العمل السياسي والتي صارت سمة القرن الواحد والعشرين منذ غزو العراق إلى يومنا هذا.
ومما يؤسف له بصدد هذا العمل السياسي، ما تسرب في السنوات الأخيرة، إلى بعض مثقفينا من قيم تلك العلمانية المتطرفة المرسخة للاعتقاد الزائف بتعارض منطق السياسة مع منطق الأخلاق. إلا أن ما يثلج الصدر حقا أن بعض الأنظمة الفكرية والسياسية التي بنيت على أساس هذا النوع من التفكير قد أصابها اليوم تصدع بعد أن افتضح أمرها وتبين زيفها ومعارضتها للقيم الأخلاقية. فقد تبين للعيان الثمن الباهض الذي دفعه بعض "المفكرين" الذين فرطوا في استقلالهم وهرعوا إلى توظيف ممارساتهم الفكرية لصالح تلك الأنظمة؛ فكان مصير العديد منهم أسوأ من مصير سلفهم "نيقولا ميكيافيلي" الذي مهما تكن حصافة فكره ودقة ملاحظاته، فقد ضرب المثل لرجل الفكر الطامح بعلمه في "الحظوة" والقرب لدى "الأمير" والمضحي بكل القيم الأخلاقية في سبيل " تقديس الدولة" ومصلحة رجل السلطة خاصة؛ فكان مصيره أن سحقته دولته وتنكر له أميره ! والذي نخشاه أن يكون بعض مثقفينا قد انتهوا هم أيضا إلى تقديس " عقل القوة" وتبرير استبداد الدولة واستهجانه موقف الجمهور الداعي إلى احترام القيم الأخلاقية. وتلك نتيجة “غالبا ما ينتهي إليها” نوع من المنظرين الرافضين للتخليق السياسي والطاعنين في مشروعية وصل السياسية بالقيم والمبادئ الإنسانية التي لا يمل الجمهور من المطالبة باحترامها وتنزيلها.
ومن تم نستطيع أن نقرر أنه لا قيام للممارسة الفكرية الفكرية الحقة إلا بحرص رجل العلم على الاحتفاظ دائما "بمسافة" تضمن له قدرا ضروريا من الاستقلالية الفكرية، وتقيه من كل تبعية قد تضطره إلى التضحية بمبادئه والتنكر لوظيفته كرجل مسؤول وصاحب "رسالة" أو دعوة يضرب بها المثل في نشدان الحقيقة والالتزام بالموضوعية والتحلي بالإنصاف والاصداع بالحق.
وأخيرا فإن عالمنا اليوم، خاصة في مراكزه الحضارية المهيمنة داخل العالم الغربي، إذا كان يعاني منذ أواخر القرن التاسع عشر، وخاصة بعد تجربته القاسية والرهيبة في الحربين العالميتين خلال القرن العشرين؛ فإن انتفاء أسباب الأمن وارتفاع وثيرة التسلح والتهديد بإفناء العالم نوويا؛ فإن في مثل ما بسطناه سابقا من مقاصد الإسلام الكبرى ونظرته الوسطية للإنسان وللمجتمع البشري ما يحملنا نحن المسلمون أن نساهم به مع ذوي النوايا الحسنة في عالم اليوم في رأب الصدع وإعادة التوازن لإنسان العصر مع نفسه ومع أخيه الإنسان، ومع الطبيعة التي انتظمت هي الأخرى مؤخرا إلى الشهادات الدالة على وجوب الإسراع بتصحيح مسيرة الإنسان وتحسين "شروط تواجده في هذا العالم" ليبرهن من جديد على استحقاقه لقب "خليفة الله في الأرض".
لابد إذن مما ليس منه بد ! لابد لنا كرجال فكر وعلم من أن نساهم في إخراج الإنسانية من حالة البطش إلى حالة التراحم، ومن حالة التلذذ إلى حالة طموح التعاطف، ومن نزعة التنافر والتباعد إلى طلب التقارب والتعارف.

أستاذ الفلسفة وتاريخ الفكر الإسلامي بكلية الآداب، جامعة محمد الخامس، الرباط. رئيس وحدة التكوين والبحث في الخطاب الصوفي في الإسلام و أبعاده التواصلية، كلية الآداب، الرباط. نائب رئيس منتدى الحكمة للمفكرين والباحثين الذي يرأسه الدكتور طـه عبد الرحمان. أستاذ العقيدة وتاريخ علم الكلام بمؤسسة دار الحديث الحسنية بالرباط. تتمحور أعماله الأكاديمية حول تاريخ الفكر الإسلامي، خاصة في الغرب الإسلامي، مع اعتناء بظرفية النشأة وأسباب التطور وإعادة النظر في مقاصد علوم الإسلام وما تراكم حولها من مناهج وقراءات ومفاهيم وقيم. ظهرت له العديد من الكتب والأبحاث في المجلات العلمية المتخصصة سواء في المغرب أو خارجه منها "إشكالية إصلاح الفكر الصوفي المغربي. الدار البيضاء ، دار الآفاق الجديدة ط 2، 1995" و"التصوف كوعي وممارسة، دراسة في الفلسفة الصوفية عند أحمد بن عجيبة، الدار البيضاء، دار الثقافة ط 2، 1999" و" في البدء كانت السياسة. الرباط، المعرفة للجميع ط 1، 2000" و"تجليات الفكر المغربي. الدار البيضاء، المدارس ط 1، 2000" و"بدايات الفكر الإسلامي، ليوسف فان إيس (ترجمة). الدار البيضاء، ألفنك ط 1، 2000" و" قناعات معرفية أم أهداف استراتيجية، مراجعة نقدية لمحاضرة بابا الفاتيكان. الرباط، دار أبي رقراق ط 1، 2008" و" الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام، قراءة في نشأة علم الأصول و مقاصد الشريعة. القاهرة، رؤية ط2، 2009" و" فقه و شرعية الاختلاف في الإسلام. القاهرة، رؤية ط 1، 2009" و" الخطاب الإصلاحي العربي بين منطق السياسة وقيم المفكر. القاهرة، رؤية ط1، 2009" و" يصدر قريبا عن كلية الآداب بالرباط القيم الإبراهيمية بين سفر التكوين و مصحف القرآن: دراسة في الشخصية القاعدية للنبي ابراهيم في اليهودية و الإسلام".
([1]) انظر الأطروحة الممتازة للدكتور عبد الرحيم حيمد: «التصوف اليهودي (القبال) والتصوف الإسلامي: دراسة مقارنة لنظريات الوجود والمعرفة في فكر موسى اللّيوني ومحيي الدين بن عربي». أﮔﺎدير:كلية الآداب، 2000-2001.
([2]) الرباط: كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ترجمة وتحقيق أحمد شحلان، ط 1، 2010.
([3]) نقلاً عن «كراسات أندلسية» الرباط: مركز دراسات الأندلس وحوار الحضارات، ط 1، 2006، القسم العربي، ص 38-39؛ القسم الفرنسي، ص 38-39.
([4]) أنظر في مدونات تفسير القرآن الكريم قديماً وحديثاً تأويل ما سماه البعض «بآية السيف» من سورة براءة !...
([5]) كانط، إيمانويل، المبادئ الأساسية لميتافيزياء الأخلاق، حلب: دار الشرق، ترجمة حكمة حمصي، تقديم عادل العوّا.
([6]) العامري، أبو الحسن، الإعلام بمناقب الإسلام، القاهرة: دار الكتاب العربي، 1387/ 1967، ص 78-79 [دراسة وتحقيق أحمد عبد الحميد غراب].
([7]) طه، عبد الرحمن، سؤال الأخلاق، الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، ط 1، 2000، ص 14.
([8]) قارن بنفس المرجع، ص 38-39.
([9]) نفسه، ص 52-54.
([10]) قرآن كريم، العنكبوت، 45.
([11]) أنظر على سبيل المثال ما جاء بخصوص ذلك في القرآن الكريم:
}وما خلقنا السماوات والأرض لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق، ولكن أكثرهم لا يعلمون{ (الدخان: 38-39).
}أيحسب الإنسان أن يترك سدى{ (القيامة، 36).
}أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا تُرجعون{ (المؤمنون، 115).
}أم حسب الذين اجترحوا السيآت أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم، ساء ما يحكمون{ (الجاثية، 21).
}وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً إقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً{ (الإسراء، 13-14).
}وُوضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا وليتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة
إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً{ (الكهف، 49).
}حتى إذا ما جاؤوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لِمَ شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة وإليه تُرجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون{ (فُصلت، 20-22).
([12]) هؤلاء البشر الذين انضافت إلى عقم تصوراتهم ومفاهيمهم الدينية والفلسفية، معاناتهم اليومية من الصراعات السياسية والحروب المتواصلة بين الإمبراطوريات المتصارعة بحيث نستطيع القول إنه «لم يكن في تلك الفترة حالة لا توصف بالسوء ولا يقال فيها بالإجمال إنه حالة فساد وانحلال». انظر: العقاد، عباس، العبقريات، القاهرة: دار الفتوح، 1957، ص. 43؛ قارن أيضاً شهادة لمؤرخ أوروبي معاصر أوردها محمد إقبال، تجديد التفكير الديني في الإسلام، القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشر، ط 2، ص 168 [ترجمة عباس محمود].
([13]) إقبال، محمد، تجديد التفكير الديني في الإسلام، مرجع سابق، ص 21.
([14]) لاحظ هنا البعد «الإنساني» والتبشير الواضح «بالمجتمع المفتوح» في قول الرسول r في حجّة الوداع: «يا أيها الناس! ألا إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب». «إن أكرمكم عند الله أتقاكم»؛ «لا فضل لعربي على عجمي، ولا أعجمي على عربي، ولا لأحمر على أبيض، ولا لأبيض على أحمر إلا بالتقوى».
([15]) انظر المراجعة النقدية لطه عبد الرحمن لتعامل الفقه القديم مع مفهوم مكارم الأخلاق ومع حديث «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» في كتابه: سؤال العمل، الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، ط 1، 2012، ص 74، 86-87.
([16]) انظر أسباب نزول الآيات 105-113 من سورة النساء؛ قارن هذا النوع من الإنصاف بموقف الإنجليزي Daniel de Morley الذي لم يقنعه معلموه في جامعة باريس فقرر الذهاب للنهل مباشرة من علوم المسلمين وارتحل إلى إسبانيا سنة 1180 م حيث كانت ترجمة تلك العلوم قائمة على قدم وساق. غير أن هذا الشخص، وقد كان يهودي الدين، لم يجد ما يبرر به «شرعية» أخذ علوم الإسلام سوى قوله: «في أيامنا هذه شاعت علوم العرب بين الناس؛ ونحن [اليهود] أيضاً الذين نجونا بمعجزة في مصر، كان الربّ قد أمرنا بسلب المصريين وتجريدهم مِمّا يملكون كي يغتني العبرانيون. وإذاً، ووفقاً لأوامر الربّ تلك وبتأييده، فلنسلب نحن اليوم أيضاً أولئك الفلاسفة الوثنيين [= المسلمين!] حكمتهم وعلومهم البليغة؛ لنسلب هؤلاء الكفار ما نغني به إيماننا» ونحقق وعدنا. أورد هذا النص Pierre Guichard من جامعة ليون بفرنسا في بحثه: "L’influence de la culture du MAGHREB et de L’Andalus sur L’Europe Latine Au Moyen Age". مجلة كراسات أندلسية، منشورات مركز دراسات الأندلس وحوار الحضارات، الرباط: العدد 1، الطبعة الأولى، 2006، ص 38 من القسم الأجنبي.
([17]) يجدر الانتباه هنا إلى أن الإسلام قد حضر إلى هذا العالم خاصة عبر «كتاب» تميّز عما قبله من سائر الكتب الدينية بأنه ليس رصداً لتاريخ شعب أو قبيلة (= التوراة) ولا سرداً لسيرة شخصية (= الإنجيل) بقدر ما هو كتاب مفاهيم وقيم كبرى بامتياز، تخاطب الناس كافة. وقد حرص الرسول الخاتم r أن يقلدها مسؤولية كبرى في عنق كل حاضر في حجّة الوداع ليبلِّغها شهادة لكل بني البشر في مستقبل الإنسانية: «فليبلِّغ الشاهد منكم الغائب»!
([18]) العقاد، عباس، العبقريات، القاهرة: دار الفتوح للطباعة، 1957، ص 118.
([19]) العبارة لربعي بن عامر، أحد قادة المسلمين في معركة «القادسية» متوجهاً بهذه الكلمات إلى القائد الفارسي «رستم». أنظر: الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج 3، ص 520.
([20]) محمد إقبال، نفس المصدر، ص 142.
([21]) نفسه، ص 144.
([22]) العقاد، ع، العبقريات، مرجع مذكور، ص 125.
([23]) لوقا، نظمي، محمد: الرسالة والرسول، القاهرة: الشركة العربية للطباعة، ط 1، 1957، ص 50.
([24]) نصر، سيد حسين، العلم الإسلامي، نقلاً عن عبد الهادي أبو ريدة «تجديد المنهج العلمي والمعرفة العلمية على يد علماء الإسلام»، ورقة مقدمة إلى المؤتمر الدولي حول العلم في السياسة الإسلامية، إسلام آباد، 19-25 نوفمبر 1983، ص 1.
([25]) ابن خلدون، عبد الرحمن، المقدمة، بيروت: دار الكتاب اللبناني، ط 3، 1967، ص 1047-1051.
([26]) انظر بصدد قيمة هذا المبدأ، كتاب مايكل كوك، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الفكر الإسلامي، بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، ط2، 2013، ترجمة ومراجعة رضوان السيد، وعبد الرحمن السالمي وعمّار الجلاّص، (910 ص).
([27]) التوراة، سفر التكوين، الإصحاح 11.
([28]) بنت الشاطئ، القرآن وقضايا الإنسان، بيروت: دار العلم للملايين، ط 1، 1972، ص95.
([29]) قرآن: البقرة، 256.
([30]) قرآن: الممتحنة، 8.
([31]) نتكلم هنا عن السماحة التي تعني خُلقاً يتضمن المطالبة «بحق المعاملة بالمثل»، وليس عن «التسامح» الذي يعني غض الطرف عن الآخر المخالف والصّبر على أذاه! فمفهوم التسامح دائماً «يُشعر بوجود التجاوز عن عثرات الآخرين أكثر مما يشعر بضرورة حفظ إرادتهم الدينية لذاتها» والتسامح في أصله لا يعني المساواة بأية حال من الأحوال؛ أنظر نقداً للمضمون الأخلاقي لمفهوم التسامح عند طه عبد الرحمن، روح الدين، الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، ط 1، 2012، ص 67-68؛ وانظر فصلاً دقيقاً بين مفهوم «السماحة» ومفهوم «التساهل» عند محمد الطاهر بن عاشور، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، تونس: الشركة التونسية للتوزيع، 1976، ص 24-27.
([32]) الشريف، قاسم عون، نشأة الدولة الإسلامية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، دراسة في وثائق العهد النبوي، بيروت: دار الكتاب اللبناني، ط 2، 1401/ 1981، ص 285-286.
([33]) مجلة الاجتهاد، بيروت: العدد 57-58، 1424/ 2003، ص 176ـ هامش 1.
([34]) قارن التوراة: سفر التثنية، 20 (10-16).
([35]) حول أهمية «المعاهدات» في العهود الإسلامية الأولى وضوابطها الأخلاقية والقانونية يُرجى الرجوع إلى كتاب السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني؛ وانظر حول بدايات تعرف الأوروبيين على قيمة المعاهدات الدولية مشروع رجل الدين المسيحي Abbe de Saint-pierre بعنوان: Projet pour rendre La Paix perpétuelle en Europe ; Paris ; Fayard, 1987.
([36]) قرآن كريم، الممتحنة، 8.
([37]) علال الفاسي، مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها؛ الرباط: مطبعة الرسالة، ط 2، 1979، ص 229.
[38] - أنظر المتابعة النقدية لبرلمان الأديان هذا في كتاب طه عبد الرحمن بسؤال العمل، الفصل الثالث.
[39] - نظمي لوقا محمد: الرسالة والرسول، مرجع سابق، ص 38.
[40] - هوفمان مراد: الإسلام كبديل، مرجع سابق، ص 60.
[41] - أنظر هنا نموذجا دالا على هذه القيم المعرفية في مقدمة الحسن بن الهيثم في كتابه" الشكوك على بطليموس"، وكذا الفقرات الأخيرة من كتاب "ميزان العمل" لأبي حامد الغزالي حول فضيلة الشك ونبد مطلق التقليد....



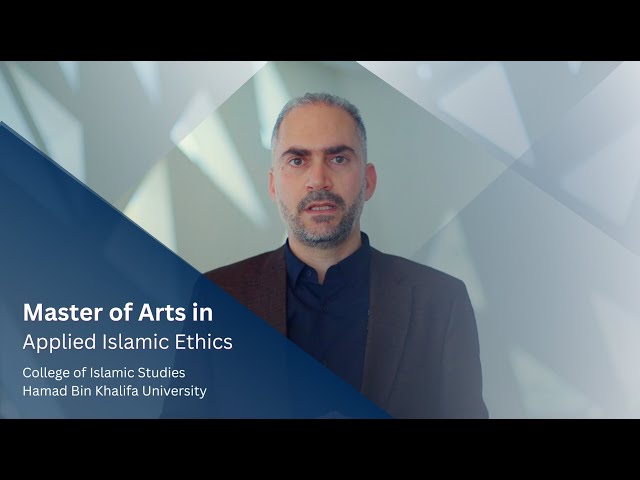






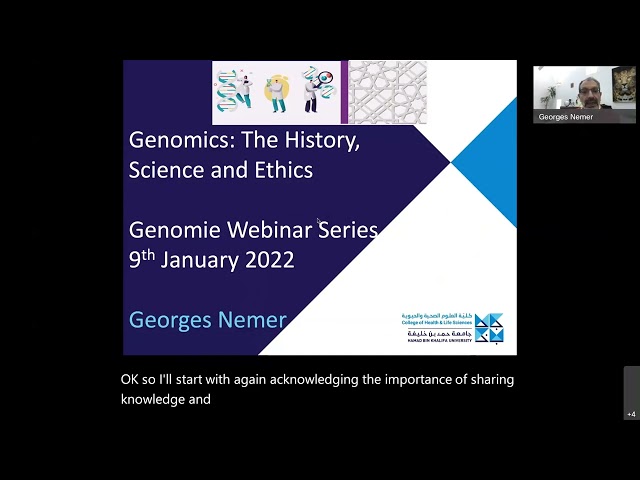
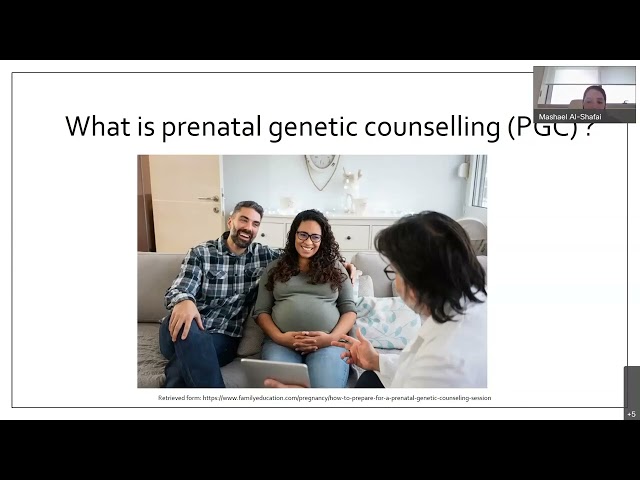
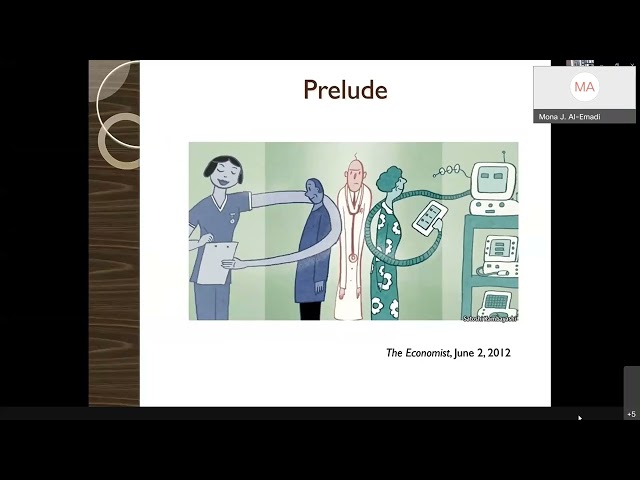

Add new comment