
د. محمد غالي
استاذ الأخلاق الطبية والحيوية في الإسلام
مركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق
كلية قطر للدراسات الإسلامية
جامعة حمد بن خليفة
التحديات الأخلاقية لمؤسسة الأسرة في عصر العلم (الجزء الثاني)
التحديات الأخلاقية لمؤسسة الأسرة في عصر العلم (خاتمة البحث)
خلاصة البحث:
يناقش هذا البحث –في جزئية الأول والثاني وفي الخاتمة- ظاهرة تنامي مساحة سلطة الطب في العصر الحديث "medicalization" وتمددها لتتشابك وتتفاعل مع غيرها من السلطات ذات المصدر الديني أو الثقافي فيما يتعلق بتدبير أمور الأسرة على وجه الخصوص. بعد مقدمة موجزة عن شكل وطبيعة الأسرة وأهمية البعد الديني فيما قبل وجود هذه الظاهرة، يركز البحث على التحديات الأخلاقية التي أبرزتها هذه الظاهرة عندما وسعت دائرة "الممكن" من الناحية الطبية وما أحدثه هذا التوسيع من تحديات حول تحديد مفهوم "المقبول" من الناحية الأخلاقية والشرعية وكيف تعامل علماء الإسلام مع هذه التحديات. وفي خاتمة البحث، يخلص الباحث إلى أن التحديات الأخلاقية التي تنتجها التقنيات الطبية والحيوية الحديثة في مجال الأسرة بشكل شبه يومي تستدعي استقراء تاما أو شبه تام لكل ما يمكن رصده من موضوعات ونماذج لهذه التحديات بغية تحديد منهج متماسك ومتناسق للتعامل مع الأسئلة المركزية التي تطرحها هذه التحديات يبدأ بتحليل النصوص الشرعية ذات الصلة وينتهي باستكشاف العلل والغايات والمقاصد التي ترسم الإطار العام لما هو مقبول/مردود من المنظور الشرعي، وذلك بهدف استيعاب ما يطرأ مستقبلا من تحديات في هذا المجال بشكل منهجي دون اللجوء إلى التعامل الآني والفردي مع كل حالة كرد فعل لما يقدمه الطب من جديد مما يجعل الصياغة المتماسكة للموقف الشرعي دائما متأخرة من الناحية الزمانية وأكثر عرضة للوقوع في تناقضات منهجية.
مقدمة:
تعارف الناس منذ القدم على أن الأسرة في الأصل ذكر وأنثى يتعاونان سويا من أجل إنجاب ذرية تتشكل منها لبنة المجتمع الأولى اصطلح عليها في العصر الحديث بمؤسسة الأسرة. ويشير القرآن الكريم إلى هذا المبدأ في أكثر من موضع، من ذلك قوله تعالى "يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً" (النساء: 1) وقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا" (الحجرات: 13). ومع تطور المعارف والعلوم، أدرك الناس أن إنجاب الذرية يقوم على شراكة بيولوجية محددة يقدم فيها الذكر "المني" وتقدم الأنثى "البييضة" و"الرحم" وينشأ الولد بعد علمية الالتقاء الجنسي أو الجماع عندما تتلاقي هذه العناصر الثلاثة التي ألمح القرآن الكريم إليها أيضا في سياقات مختلفة منها "إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ" (الإنسان: 2) فأكثر المفسرين -كما ذكر فخر الدين الرازي- على أن لفظة "أمشاج" في الآية تشير إلى اختلاط نطفة الرجل بنطفة المرأة ومنها كذلك قوله تعالى "ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ" (المؤمنون: 13)، إشارة إلى رحم المرأة الذي يتخذه الجنين مستقرا خلال فترة الحمل.
البعد الديني لمؤسسة الأسرة
وعلى الرغم من إدراك البشرية منذ القدم لإمكان إنجاب الذرية وتأسيس الأسرة بمجرد وجود ذكر وأنثى أو عناصر المشاركة البيولوجية بينهما إلا أن أديان الناس ومعتقداتهم وأعرافهم وثقافاتهم دائما ما فَرَّقَت بين هذا "الإمكان" الموجود في الطبيعة من ناحية و"المعيار الأخلاقي" المطلوب مراعاته من ناحية أخرى والذي كان الغرض الأساسي منه إضفاء صبغة القبول على مؤسسة الأسرة هذه لدى مجموعة من الناس أو أمة من الأمم.
ففي الإسلام كان إطار عقد الزواج الشرعي الصحيح أو "الميثاق الغليظ" كما أسماه القرآن هو الإطار الرئيسي العام الذي يُسمح من خلاله بتكوين الأسرة، وحتى داخل هذا الإطار وضع الإسلام بعض المعايير التي حث أتباعه على الالتزام بها أثناء اختيار شريك الحياة ومن ذلك قول النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة –رضي الله عنه- "تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك" فلفظ "تنكح" يشير إلى الإطار العام المقبول من الناحية الشرعية ألا وهو النكاح ثم يتحدث النص عن أربعة معايير إضافية تقع داخل هذا الإطار ويرجح الإسلام منها معيار الدين. وفيما يتعلق بالرجل أيضا ذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره وحسنه جمع من العلماء "إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض"، فدلت هذه النصوص على حتمية الإطار العام المقبول ألا وهو الزواج وعلى مركزية معيار الدين والخلق عند اختيار شريك الحياة.
البعد الطبي والبيولوجي لمؤسسة الأسرة: ظاهرة تمدد سلطة الطب "medicalization" في العصر الحديث
في سبعينات القرن الماضي، ظهر مصطلح "medicalization" بين علماء الاجتماع الغربيين ويقصدون به تنامي سلطة الطب في العصر الحديث بفضل التقدم الكبير لتقنياته بحيث أصبح يتم التعامل مع كثير من أوضاع الإنسان وسلوكياته ومشكلاته من منظور طبي، وبالتالي تصبح جزءا من موضوعات علم الطب التي تخضع للفحص والتدخل والعلاج الطبي بالرغم من أن دور الطب فيما يتعلق بهذه الأمور ظل هامشيا أو ربما غائبا بالكلية في السابق.
ومؤسسة الأسرة هي أحد ابرز الأمثلة التي توضح مدى تمدد سلطة الطب وولوجها إلى كثير من شؤون الأسرة التي كان تدبيرها في السابق خاضعا لأبعاد دينية وثقافية في الأساس. وسنرى أن هذا التوسع لسلطة الطب سيخلق أوضاعا وأرضية جديدة فيما يتعلق بتأسيس الأسرة وتحديد أشكالها وأنماطها وهذا بدوره سيطرح تحديات أخلاقية تستدعي تفاعلا وتشابكا مِن جانب مَن كانت له سلطة تقييد "الممكن" من الناحية الطبيعية ونخص بالحديث هنا الجانب الديني وهو ما صاغه علماء الإسلام فميا اصطلح عليه بضرورة ممارسة "الاجتهاد" لمعالجة القضايا والتحديات الأخلاقية التي أوجدها أو أبرزها الطب الحديث.
ونلقي الضوء في هذا البحث على أمرين رئيسيين أبرزا أهمية البعد الطبي في أمور الأسرة عندما (1) وسَّع التقدم الطبي دائرة "الممكن" من الناحية العملية بأن أتاح لمجموعات جديدة من الأشخاص إنجاب ذرية رغم أن أمثالهم في السابق كانوا محرومين من هذه النعمة وهذا المحور هو موضوع الجزء الأول من هذا البحث أو (2) ضيِّق دائرة "الممكن" بأن قَدَّم من الأطروحات ما يفيد بأن بعض الأشخاص لا ينبغي أن يقدموا على إنجاب الذرية–لاعتبارات تتعلق بتركيبتهم الجينية- بالرغم من عدم وجود مانع من الناحية الدينية أو الثقافية، وهذا المحور هو موضوع الجزء الثاني من هذا البحث. وسنرى أن هذا التوسيع أو التضييق لدائرة "الممكن" من جابب الطب قد طرح تحديات أخلاقية تتعلق برسم حدود المقبول/المردود شرعا مما استدعى اجتهادا من قبل علماء الإسلام كان في القلب منه الموقف من تمدد سلطة الطب وولوجها في مواطن كان للدين والمجتمع فيها الكلمة العليا أو ربما الكلمة الوحيدة سابقا.
توسيع دائرة "الممكن" من الناحية الطبية: تقنية التلقيح الصناعي نموذجا
في سبعينات القرن الماضي -وهي ذات الحقبة التي ظهر فيها مصطلح medicalization- خطا الطب خطوة واسعة نحو بسط سلطته في ميدان الأسرة عندما نجح الطبيبان البريطانيان باتريك ستبتو (ت. 1988) وروبرت إدواردز (ت. 2013) في استخدام تقنية التلقيح الصناعي "In vitro fertilization (IVF)"-وهو جزء مما يعرف بتكنولوجيا الإخصاب المساعد "Assisted Reproductive Technology (ART)"- لتلقيح يبيضة خارج الرحم والتي عن طريقها ولدت لويز براون في الخامس والعشرين من يوليو عام 1978 كأول طفلة في العالم تأتي إلى دنيا الناس بهذه الطريقة. الحدث أقام الدنيا في ذلك الوقت ولم يقعدها حتى الآن فحصل روبرت إدواردز على جائزة نوبل في الطب عام 2010 كتقدير للإنجاز العلمي الذي قام به ولازال علماء الدين والاجتماع وغيرهم يحاولون التعامل مع تداعيات هذا الحدث الجلل، ونحن هنا نركز على ما له علاقة بشؤون الأسرة والدور الجديد للمعارف الطبية فيها.
تقنيات الإخصاب المساعد أو الصناعي –كما يطلق عليها أحيانا- أثبتت أن الحصول على ذرية لا يتطلب بالضرورة أن يحدث التقاء جنسي أو جماع بين الذكر والأنثى، فعن طريق هذه التقنيات يمكن تلقيح بييضة المرأة بمني الرجل في المختبر ثم تحقن في رحم المرأة وينشأ الحمل. وبالتالي صار من الممكن نظريا أن يتم تأسيس أسرة بها أولاد إذا ما حصلنا على هذه العناصر الثلاثة فقط: "مني" من الرجل، و"بييضة" من المرأة و"رحم" تغرس فيه البييضة عقب إتمام التلقيح الصناعي دونما حاجة إلى عملية الجماع التي كان يتم من خلالها تلقيح البييضة بشكل "طبيعي". فالرجال الذين يعانون من ضعف الحيوانات المنوية والنساء اللاتي يعانين من انسداد قناة فالوب يمكنهم الآن وعن طريق هذه التقنيات الجديدة أن يكوِّنوا أُسراً يقومون فيها بدور الآباء والأمهات. فماذا كان موقف الفقهاء من توسيع الطب لدائرة "الممكن" وكيف تعاملوا مع القضايا الأخلاقية التي أفرزتها علمية التوسيع هذه؟
بدلا من الخوض في تفاصيل المواقف التي تبناها كل عالم أو مجمع فقهي على حدة، وهو أمر لا تسمح به المساحة المخصصة لهذا البحث وليس هو أحد أهدافه أو مقاصده، نؤثر الحديث عن ثلاث مجموعات أو فرق رئيسية تضم جل أصحاب هذه المواقف إن لم يكن كلها وهي فريق المضيقين ويقابلهم فريق الموسعين وبينهما فريق ثالث حاول تبني موقف وسط بين هذين الطرفين هو فريق المتوسطين. والأمر الجامع بين الفرق الثلاث هو اشتراط وجود عقد نكاح شرعي بين الرجل والمرأة الراغبين في الإنجاب، وبالتالي لا أسرة بلا نكاح ولا نكاح إلا بين رجل وامرأة عند الجميع.
فريق المضيقين
بالنسبة لفريق المضيقين، بدا تدخل الطب من خلال هذه التقنية الجديدة في عملية الإنجاب وتشكيل الأسرة أمرا مرفوضا من أساسه حتى وإن كان بين المتزوجين وبأي صورة كانت، وبالتالي استبعاد أي دور للطب في هذا الموضوع. ولم يتبن هذا الموقف-فيما أعلم- سوى بعض آحاد من علماء المسلمين وخاصة عندما كان النقاش حول التلقيح الصناعي في بداياته ويتعلق بالتنظير لأمر افتراضي لم يكن قد تحقق في أرض الواقع بعد.
ومن بين هؤلاء الشيخ أحمد الحجي الكردي الذي نشر مقالا حول الموضوع عام 1971 في مجلة "الوعي الإسلامي" الكويتية وضح فيه جليا الشعور بالقلق حول إمكانية تزاحم السلطات بين الطب والشريعة في حال نجحت هذه التقنية في المجال التطبيقي، حيث طالب علماء الشريعة بدراسة هذه التقنية الحديثة وببيان حكم الإسلام فيها وأضاف "وعلى ضوء هذا الحكم الذي يتفقون عليه ينبغي على الطب والعلم أن يتابع طريقه أو يتوقف عن متابعة التجارب، أو على الأقل على العلماء والأطباء المسلمين ومن يؤمن ويعتقد بعالمية الشريعة الإسلامية ودقة أحكامها أن يلتزم بذلك. وعلى غيرهم أن يستنير بهذا الحكم فيكون منبها له يضع أصابعه على مواطن الخطر فيما هو بصدده من أبحاث وتجارب" وبالتالي فالطب هنا يمكنه أن يوسع دائرة "الممكن" فقط عندما تسمح له الشريعة بذلك. وقد ذكر الشيخ الكردي عددا من الحجج التي استند إليها في اعتراضه على هذه التقينه منها القاعدة الفقهية "الأصل في الفروج التحريم" ومنها مبدأ الكرامة الإنسانية للطفل التي يهدرها هذا النوع من التكنولوجيا حيث قال " أي كرامة لذلك الطفل الذي يصنع في أنبوبة الاختبار وينمى كما تنمى فراخ الدجاج تماما دونما فارق بينهما". كما أشار الشيخ الكردي في معرض كلامه إلى مركزية العلاقة الجنسية بين الزوجين وأن الغاية منها أمران: أولها تأمين السكن النفسي الناتج عن المتعة الجنسية والعاطفية وثانيها انجاب الأطفال مضيفا أن التلقيح الصناعي يحقق الأمر الثاني لكنه لا يحقق الأول والثاني لا يُقبل إلا بعد تحقق الأول.
وهذه الحجة الأخيرة على وجه الخصوص لم تلق رواجا بين عامة علماء المسلمين المعاصرين حتى أن الشيخ الكردي ذاته تراجع عن فتواه هذه في مقال آخر نشره في نفس المجلة بعد حوالي ثلاثين عاما. لكن هذه الحجة لا تزال مركزية إلى اليوم في خطاب علماء أديان ومذاهب أخرى. فالكنيسة الكاثوليكية مثلا ترى أن هذه التقنية- حتى وإن كانت بين زوج وزوجة- لا تتوافق مع القانون الأخلاقي الطبيعي "natural moral law" الذي يقتضي أنه لا جماع إلا بغرض الإنجاب وبالتالي يكون الإنجاب من دون جماع أمرا "غير طبيعي". بل إن الكنيسة أدانت حصول روبرت إدواردز على جائزة نوبل في الطب وصرحوا بأن الحياة الإنسانية يجب أن تبدأ بطريق الجماع الطبيعي لا بالطرق والتقنيات الصناعية.
فريق الموسعين
وعلى عكس المضيقين، لم ير فريق الموسعين بأسا من فتح الباب لتمدد المساحة التي يمكن للطب بتقنياته الحديثة أن يتدخل ليعالج بعض شؤون الأسرة، فأجازوا جل أو كل صور التلقيح الصناعي وبالتالي صار تقريبا كل "ممكن" من الناحية الطبية "مقبولا" من الناحية الأخلاقية. فعند كثير من علماء الشيعة لا بأس أن يستعين الزوجان ببييضة أو رحم من امرأة متبرعة بل وأجاز البعض -مثل علي خامنئي المرشد الأعلى للثورة الإسلامية بإيران- الاستعانة بمني من رجل متبرع بغرض الحصول على الولد طالما أن الراغبين في الحصول على الولد يجمعهما عقد زواج شرعي ومنه – في المذهب الشيعي- عقد نكاح المتعة المؤقت بزمن معين تنفك بعده رابطة النكاح تلقائيا. ونجد صعوبة في استكشاف العلل والغايات التي بنى عليها هؤلاء العلماء موافقهم فمعظم فتاويهم غاية في الاختصار لا تتعدى ألفاظا معدودة مثل "لا مانع شرعا" أو "يجوز ذلك". ولكن يبدو -والله أعلم- أن مبدأ "تحقيق المصلحة" والمعني به في هذا السياق تحصيل الولد عن طريق هذه التقنية الطبية الحديثة قد جعل عددا من الفقهاء يميل إلى ترك مهمة ترسيم حدود المصلحة المسموح بها للطب وللطب وحده وليس للشريعة من شرط في هذا الأمر إلا أن يتم التلقيح الصناعي بين زوجين، حتى أن تحديد النسب في هذه الحالات بناء على العناصر البيولوجية فالأب هو صاحب المني والأم هي صاحبة البييضة،. وهكذا ذهبت السلطة بشكل شبه كامل إلى علم الطب وحده، حتى أنهم في المسائل المتعلقة بالنسب اعتمدوا كذلك على المعايير الطبية، فجعلوا الأب هو صاحب المني والأم هي صاحبة البييضة، غاضين الطرف عن معيار فراش الزوجية الذي ظل مركزيا في الخطاب الشرعي ولاذي يقتصي بأن يكون الزوج هو الأب والزوجة هي الأم. وقد علمنا فيما سبق أن صاحب المني –في بعض الصور المجازة من قبل فريق الموسعين- قد لا يكون زوجا شرعيا لصاحبة البييضة وبالتالي صار شرط وجود رابطة الزوجية مسألة شكلية تماما حيث يمكن أن يُنَسَّب الولد هنا لأب وأم لا رابطة زوجية تجمع بينهما.
فريق المتوسطين
أما جمهور علماء المسلمين السنة فاتخذوا موقفا وسطا بين المضيقين والموسعين. فرأوا –خلافا لفريق المضيقين- أنه لا إشكال في حدوث الحمل من دون جماع، وبالتالي لم يروا بأسا بتدخل الطب بهذا القدر الذي يجعل عملية الجماع أمرا ثانويا في قضية الإنجاب بعد أن كان مركزيا في السابق. إلا أنهم اشترطوا إلى جانب وجود رابطة النكاح الشرعي بين الرجل والمرأة الراغبين في الإنجاب عن طريق التلقيح الصناعي –خلافا لفريق الموسعين- ألا يتدخل طرف ثالث من خارج إطار الزوجية عن طريق التبرع بمني أو بييضة أو رحم. وهذا الموقف الوسط لا يخلو هو الآخر من الإشكالات الأخلاقية التي تتطلب التعامل معها، فقد أعطى للطب مساحة في مجال الأسرة لم يسمح بها المضيقين ولكنه أيضا لم يعطه كل المساحة التي أقر بها الموسعون. فكيف تعامل أنصار هذا الموقف الوسط مع المناطق الشائكة في العلاقة بين الشريعة والطب؟
لا شك أن تقنيات الإخصاب المساعد أثارت أسئلة كثيرة ومعقدة لدي هذا الفريق الوسط استدعت مزيدا من البحث والمراجعة حول ماهية شرط "عدم تدخل طرف ثالث من خارج إطار الزوجية". فمع إمكانية تجميد البييضات الملحقة وحفظها ربما لسنوات ممتدة صار السؤال: ما مدى قبول فكرة غرس البييضة الملحقة في رحم المرأة بعد انتهاء عقد الزوجية سواء بالطلاق أو بوفاة الزوج وهو أمر ممكن من الناحية العملية؟ وردا على هذا السؤال اختلف هؤلاء الفقهاء، فقليل منهم قال بجواز هذه الصورة فقط في فترة العدة لأن الرجل لا يزال في حكم الزوج للمرأة، على الأقل بوجه ما من الوجوه، وجمهورهم قال بعدم الجواز مطلقا لأنه في النهاية إنجاب بين رجل وامرأة لا تربطهما علاقة زواج شرعي قائم وقت حدوث الحمل وبالتالي يؤدي ذلك إلى اختلاط الأنساب. إلا أنهم اختلفوا في تكييف الصورة إذا حدثت في الواقع فهل يعد مثل هذا الفعل "زنا"؟ فأجاب بعضهم بالإيجاب ورأى أنه "زنا من كل وجه" لأن المقصد من تحريم الزنا هو منع اختلاط الأنساب وقد أدت هذه الصورة إلى اختلاط الأنساب فلا فرق بين الفعلين من حيث المآل، في حين أجاب البعض الآخر بالنفي وأن الزنا لا يتطابق مع هذه الصورة من التلقيح الصناعي لعدم وجود عملية الجماع المباشر بين الرجل والمرأة والتي هي عنصر مركزي في تجريم الزنا وفريق ثالث أسماها "زنا مقنعا" أو ذكر أن "فيها معنى الزنا". وهنا نلمس جنوح الفريق الوسط هنا إلى التضييق فيما يتعلق بالمساحة المسموح بها للطب فرأى أن تشكيل الأسرة بهذه الصورة أمر غير مقبول شرعا حتى وإن كان ممكنا من الناحية العملية. ومع تقليص دور الطب هنا، نرى أن فقهاء هذا الفريق مالوا إلى إقصائه كذلك في القضايا المتعلقة بالنسب في هذه الحالة، فبالرغم من أن المني من الزوج السابق (مما يعني أنه هو الوالد من الناحية البيولوجية) فقد تم استبعاد أثر الناحية البيولوجية هنا عندما تم تكييف هذه الصورة على أنها علاقة زنا أو "أمر في معنى الزنا" فهذه العلاقة المحرمة لا يثبت بها نسب من الناحية الشرعية.
كما ظهرت الحاجة الملحة إلى مزيد من التحديد لماهية الشرط ذاته وهو "عدم تدخل طرف ثالث من خارج إطار الزوجية" عند استخدام تقينة التلقيح الصناعي في حال تعدد الزوجات. فماذا لو تزوج رجل بامرأتين إحداهما تستطيع إفراز البييضات ولكنها لا تستطيع الحمل لمشاكل في الرحم مثلا، فتبرعت ضرتها بالحمل لأجلها ورضيت بأن يُغرس في رحمها بييضة ضرتها الملقحة بمني الزوج المشترك بينهما؟ ففي هذه الصورة تتدخل التقنية الطبية لتسمح لهذه المرأة التي تعاني من مشاكل في الرحم بأن ينشأ ولد مكون من بييضتها ومني زوجها لكن هذا يتطلب "تعاونا بيولوجيا" من ضرتها التي ستتبرع لها بحمل هذه البييضة الملقحة في رحمها حتى تتم الولادة، فهل تمثل هذه الصورة خرقا للشرط القاضي بعدم تدخل طرف ثالث من خارج إطار الزوجية في عملية التلقيح الصناعي؟
ونلحظ هنا صعوبة واضحة في التعامل مع هذه النازلة حتى فيما صدر من مجامع فقهية مثل المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة. ففي دورته الخامسة المنعقدة عام 1982، لم يتم التوصل إلى قرار وأرجأ المجمع البت في الموضوع لدورة قادمة "ليتمكن من استيعاب أوسع، وتمحيص أكثر في مختلف جوانبه، واحتمالاته وأبعاده، وليأتي الرأي الفقهي فيه أبعد عن الابتسار، وأقرب إلى الصواب في معرفة حكم الشريعة الإسلامية بإذن الله تعالى". وفي دورته السابعة المنعقدة عام 1984 أصدر المجمع قرارا يقضي بجواز هذه الصورة وأنه لا يوجد مانع شرعي يدعو إلى حظر هذا الذي جعله الطب ممكنا من الناحيتين العلمية والعملية. ومع الميل إلى توسيع سلطة الطب هنا وتدخلها في إمكان تأسيس أسرة لهذه المرأة بمساعدة من ضرتها، كان طبيعيا أن يتم ترتيب أمور النسب وفق المعارف الطبية أيضا كما صنع فريق الموسعين وبالتالي قرر المجمع أن الأم التي ينتسب إليها الطفل هي المرأة صاحبة البييضة وأنه يثبت بينهما الإرث وغيره من الأحكام المتعلقة بين الولد ومن التحق نسبه به. أما ضرتها المتبرعة بالحمل فستكون الأم الرضاعية للطفل "لأنه اكتسب من جسمها وعضويتها أكثر مما يكتسب الرضيع من مرضعته في نصاب الرضاع الذي يحرم به ما يحرم من النسب". ولا يخفى ما في هذا الحكم من ضرورة تأويل نصوص ظاهرة –إلا أنها ليست قطعية الدلالة- تفيد بأن الحمل والولادة من علامات أمومة النسب وليس الرضاع ومن ذلك قوله تعالى "وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا" (الإسراء: 15) وقوله تعالى "إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ" (المجادلة: 2). ولا شك أن تأويل هذه الآيات وصرفها عن ظاهرها لم يحدث إلا تحت ضغط المعارف الطبية التي نقلها الأطباء الذين شاركوا في دورة المجمع إلى علماء الشريعة وبالتالي فالحديث عن تمدد سلطة الطب أمر لا مراء فيه هنا.
واللافت للانتباه أن المجمع ذاته أعاد النظر في هذه الفتوى أثناء دورته التالية مباشرة وهي الدورة الثامنة المنعقدة عام 1985 وذلك بناء على ملاحظات أبداها بعض أعضائه حول الفتوى السابقة، وجميعها ملاحظات ذات صلة بإشكالية إثبات أمومة النسب بناء على المعيار الطبي القاضي بأن أم النسب هي المرأة صاحبة البييضة: "فالزوجة التي تبرعت بالحمل وزرعت فيها لقيحة بييضة الزوجة الأولى قد تحمل ثانية قبل انسداد رحمها على حمل اللقيحة من معاشرة الزوج لها في فترة متقاربة من زرع اللقيحة ثم تلد توأمين، ولا يعلم ولد اللقيحة من ولد معاشرة الزوج، كما لا تعلم أم ولد اللقيحة التي أخذت منها البييضة من أم ولد معاشرة الزوج! كما قد تموت علقة أو مضغة أحد الحملين ولا تسقط إلا مع ولادة الحمل الآخر الذي لا يعلم أيضاً أهو ولد اللقيحة أم حمل معاشرة الزوج ويوجب ذلك من اختلاط الأنساب لجهة الأم الحقيقية لكل من الحملين، والتباس ما يترتب على ذلك من أحكام وإن ذلك كله يوجب توقف المجمع عن الحكم في الحالة المذكورة".
وهذه الملاحظات لها وجاهتها فهي تبرز مدى الإشكال في الاعتماد على معيار البييضة لإثبات أمومة النسب حيث أن المرأة المتبرعة بالحمل/الرحم قد تكون صاحبة بييضة كذلك في بعض حالات هذه الصورة وإن كانت نادرة الحدوث. إلا أنه من المعلوم أيضا أن تفادي هذا الإشكال في مثل هذه الحالات النادرة أمر ممكن أيضا، وذلك بأن يحرص الزوج مثلا على أن لا يجامع زوجته المتبرعة بالحمل لفترة تجعل احتمال تلقيح منيه لبييضتها قُبَيل أو بُعَيد عملية التلقيح منعدما. أيضا إذا أخذنا المعارف الطبية معيارا لإثبات النسب، فيمكن أن يطالب علماء الطب والبيولوجيا بتوفير الأدوات العلمية التي تعينهم على الفصل في هذه الحالات الشائكة والتحقق من أن الولد ناتج من بييضة المرأة المتبرعة بالحمل أو بييضة ضرتها التي غرست في رحمها. إلا أن المجمع لم يدخل في هذه التفاصيل وقرر أن هذه الإشكالات توجب سحب الفتوى السابقة التي قضت بجواز هذه الصورة. و يبدو لي –والله أعلم- أن هذا الموقف يعبر أيضا عن تخوف لدى علماء الشريعة من تمدد سلطة الطب بشكل يصعب وربما يتعذر السيطرة عليه مستقبلا. ففي مثل هذه الحالات الشائكة التي قد تتعقد أكثر فأكثر مع مضي الزمن سيتنامى دور المعارف الطبية في حسم القضايا المتعلقة بها وربما لن يتبقى من كلمة للشرع في المسألة إلا الموافقة أو طلب بعض التعديلات الشكلية، وبالتالي كان الخيار الأمثل أمام هؤلاء الفقهاء هو غلق هذا الباب والقول بعدم جواز هذه الصورة تحت مسمى "سد الذريعة" كما يصطلح عليه العلماء أحيانا.
تابع بقية البحث في الجزء الثاني
[*] تم تقديم هذا البحث خلال الندوة العامة "الأسرة في عصر العلم: التحديات الأخلاقية بين المفاهيم الإسلامية والمعارف الطبية" والتي عقدها مركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق بكلية الدراسات الإسلامية بقطر بالتعاون مع جامعة جورجتاون بقطر، وذلك يوم الأربعاء 7 أكتوبر 2015.



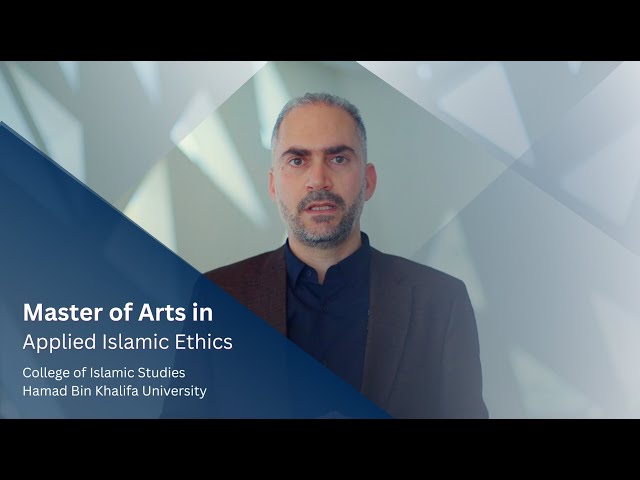






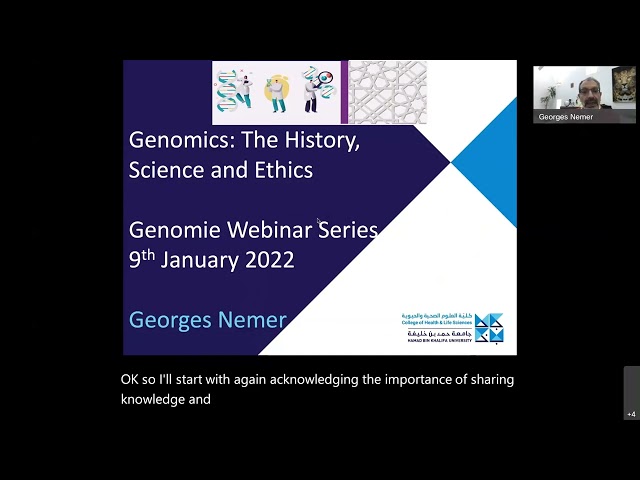
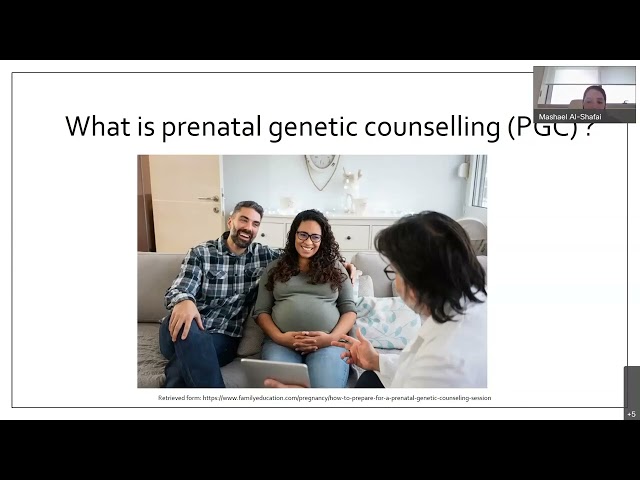
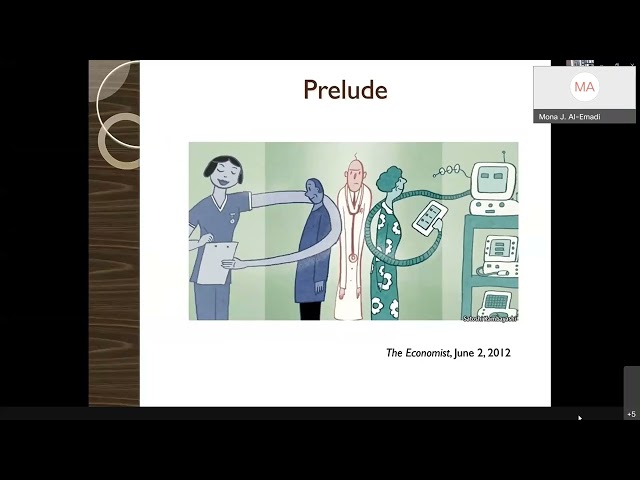

إضافة تعليق جديد